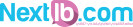للفاتيكان حساباتٌ دقيقة. ليس عن عبثٍ يجيء البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، عبر أول تحرّكٍ له بعد انتخابه في شهر أيار مايو الفائت. إنه يجيء في وقتٍ حاسم. في وقتٍ حُسمت فيه الأمور في لبنان. وفي وقتٍ يتحرّك فيه الشرق. والكرسي الرسولي مراقب دائم ودقيق على مستوى التاريخ.
ولبنان، هذا الكيان الفريد في الشرق، لا بل في العالم، كان يمثّل لدى يوحنّا بولس الثاني ما يمثّله بلده الأصلي بولونيا، التي واجهت المصائر المأساوية المختلفة، كان آخرها منتصف القرن الماضي، ما بين جارَيها روسيا السوفياتية مع ستالين وألمانيا النازية مع هتلر. وخرج ذلك البابا الصلب من قلب هذه المعاناة المزدوجة وغيّر العالم. ووجد في لبنان أثناء سنوات محنته ما يشبه بلده الأصلي، فما لبث أن وصفه بأنه أكثر من وطن بل إنه رسالة، رسالة حرّية ونموذج في التعددية للشرق كما للغرب كما صار معروفًا.
لقد حوّله بعض من في الخارج وبعض من في الداخل إلى ساحة صراع. إذ لم ينسَ اللبنانيون ذلك المشهد المذلّ في السنة الماضية حين شاهدوا مقاتلي الحوثيين، نعم الحوثيون اليمنيون يتجوّلون في ساحة شهدائهم والخناجر في وسطهم. والبعض لا ينسون ذلك المسؤول الليبي عبد السلام جلّود نائب معمّر القذافي الذي أقام خلال سنوات الحروب زمنًا طويلًا في بيروت يراقب مصالح ليبيا في ساحة الصراع اللبنانية، إلى درجة أن أصدقاءه وجدوا له عروسًا لبنانية ما دام أنه مقيم في لبنان. إذ كان آخر من عبث به تلك اليد الإيرانية الثقيلة والغريبة بعد اليد السورية المغمّسة بالدماء التي طالت القادة أولًا من كمال جنبلاط إلى بشير الجميّل إلى رينيه معوّض إلى رفيق الحريري، فضلًا عن كلّ الشهداء الآخرين. عبث النظام الأسدي طوال أربعين عامًا داخل سوريا وداخل لبنان. يكفي مظالم المخفيين ومآسي الذين غابوا تحت التراب ثمنًا لاستمرار النظام الذي كانت قضيته البقاء ولو بأنهار الدماء. واستمرّ إزاء صمت العالم كلّه. إلى أن أزفت ساعة التغيير التي لا يعرف حتى الآن من قرّرها وكيف تمّت، وما هو مستقبلها، إذ لم ينقضِ بعد عليها سوى عشرة أشهر.
ولكن أين هو لبنان اليوم؟
البابا لا يحضر ليكتشف لبنان. إنه يعرفه كما عرفه أسلافه منذ أجيال. إنه الكيان الإنساني الأول في الشرق. إنه تجربة الحرّية التي لا تجربة غيرها فيه. إنه خميرة الرسوخ المسيحي بعدما نزح من كان جزءًا أساسيًا من النسيج البشري في العراق وسوريا وفلسطين. إنه نقطة الضوء الباقية فيه. إنه، كما هو، كما نشأ وتطوّر، علامة الزمان الراسخ الذي لا يتبدّل. إن البابا يحضر ليردّه إلى أصله. وقد عرفه من خلال أبنائه المنتشرين في البيرو التي خدم فيها سنوات طويلة كما في أميركا اللاتينية بعد الولايات المتّحدة موطنه الأصلي. كما عرفه من خلال ذكره عشرات المرّات في الكتاب المقدّس. إنه يجيء ليحرّره من أولئك الذين أدانهم سلفه البابا فرنسيس في خطبته الشهيرة في كاتدرائية القدّيس بطرس في أيلول 2021 أمام رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية عندما دعا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الخاصة. إنه الموضوع الأساسي الذي ما زال يُعيق قيام الدولة وحماية هذا الوطن الرسالة.
كيف يستقيم هذا الوطن المعدّ ليكون رسالة للشرق كما للغرب، مع مسؤولين لا همّ لهم سوى مصالحهم. هؤلاء دفعوا فؤاد شهاب الرئيس المرجع للبنانيين كافة إلى عدم التجديد لدى انتهاء ولايته عام 1964، واصفًا إياهم بأكلة الجبنة، وما زالوا حاضرين. وما زالوا يأكلون. زاد في فسادهم ما أضافته الوصاية على نفسها وعليهم. إذ أن جميع ضباط ذلك الزمن الأسود أثروا، وهم القادمون من مجتمعٍ أقل ما يقال عنه أنه مختلف. فشاهدوا الحرّيات ولو مشوّهة، وهم المحرومون حتى من حق الكلام. وشاهدوا الممارسات كلّها فدخلوا في التفاصيل كلّها. ووصلت الأمور بالمخابرات السورية المعروفة، حدّ المراقبة الدقيقة لبكركي أيام البطريرك نصرالله صفير، وحدّ مراقبة الرهبانيات، فضلًا عن كلّ المراجع الدينية المسيحية. أما المراجع الإسلامية فقد قوبلت معارضتها بالعنف الدموي. والحالات معروفة.
من ذلك الاتّفاق العائد لخريف عام 1969 الذي أباح العمل الفدائي للفلسطينيين المعروف باتّفاق القاهرة وما قبله وما بعده حتى صيف 1982 موعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان، وقد دفع لبنان أفدح الأثمان العربية في سبيل ما عُرف حتى الأمس بالقضية الفلسطينة، إلى السوري، إلى الإيراني، متى يحين إعادة هذا البلد إلى نفسه. ومتى وكيف تُقفل الساحة ويتم تسييج لبنان بعيدًا عن طروحات البعض في الانقسام والتباعد وتعديل النصوص.
متى يكفّ اللبنانيون عن انتظار القرار من الخارج، متى يكفّ طوم باراك وأمثاله عن الحضور. متى يكفّ تسمية الرؤساء من الخارج. المرة الوحيدة حصلت في صيف 1970 حين فاز سليمان فرنجية على الياس سركيس بأكثرية الصوت الواحد حين الانقسام السياسي بين “النهج” و”الحلف” وهذا حصل لأنه قبل ذلك، ومنذ الاستقلال، وحتى انتخاب فؤاد شهاب تمّ باتفاق جمال عبد الناصر والموفد الأميركي ريتشارد مورفي. ويومها في جلسة الانتخاب وقف العميد الصلب ريمون أده معترضًا على ذلك الاتفاق والإجماع وواجه فؤاد شهاب لا لشيء إلا لكي يبرهن أننا نعيش في بلدٍ ديمقراطي. والباقي في سنوات الحروب حتى الأمس القريب كله معروف.
يا للفظاعة! منذ أيام مرّت سنتان على 7 تشرين الأول 2023. وعلى حرب الإسناد الكارثية التي كان آخر من دفع ثمنها، بالإضافة إلى آلاف الضحايا والدمار، ذلك المواطن التعس حسن عطوي الذي فقد نظره منذ سنة في تفجيرات “بايجر” فما عاد قادرًا على القيادة. فلاحقته المسيّرة الإسرائيلية إلى ساحة النبطية وقضت عليه مع زوجته زينب أرسلان التي كانت تقود السيارة بعدما قُتل ولدهما قبل ذلك. يا للفظاعة!
أين العلّة؟ إنها معروفة. لا بل أين الحلّ؟ إنه معروف أيضًا. إنه في الكبار لأن اللبنانيين لا يعيشون من الأوصاف تُطلق على بلدهم، ولا من التاريخ الأصيل، ولا حتى من ذكر لبنان عشرات المرات في الكتاب المقدس. ولا من قصائد أحمد شوقي وبدوي الجبل والشاعر العراقي حافظ جميل ونزار قباني و “ست الدنيا” و”جارة الوادي” إنه يعيش ويستمر ويواجه المستقبل بإنجازٍ وحيد لا غير وهو إرساء قواعد الدولة ودولة الحق، وإحقاق الحق عبر محاسبة الفاسدين والمقصرين. وإلا ليس لنا سوى صلوات البابا وأمثاله من المؤمنين، لا بل من القديسين. وهم كثر في لبنان وإلا لما استمر.