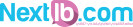نشأت الديبلوماسية السورية لمى أحمد اسكندر أحمد وهي من مواليد دمشق في عام 78 في بيت تتصدرّه صورة حافظ الأسد، وهي إبنة وزير الإعلام الأشهر في حقبة آل الأسد ، أحمد اسكندر أحمد. لذلك ربما جاء انشقاقها عن النظام عصيّاً على التصديق. كيف، وهي الديبلوماسية، التي كلّفت بوظيفة قنصل في إسلام آباد، العلوية، إبنة الوزير الذي يقال إنه صانع أسطورة حافظ الأسد في مخيلة السوريين.
إلا أنها أرادت أن تجعل من كل ذلك جزءاً من رسالتها عند الإنشقاق، الذي جاء في حزيران/يونيو من عام 2013، بعد شهور من التحضير مع الجيش الحر.
إنها ترى في حالتها نموذجاً عن كثير من المؤيدين الذين لا يعرفون حقيقة ما يجري. تقول ” تخيل أنني لم أسمع بما حدث في تل الزعتر إلا في عام 2000، وكانت تلك صدمتي الأولى”.
وهنا تفسر اسكندر أحمد المناخ الذي تربّت فيه ” كان والدي وزيراً للإعلام لعشر سنوات (من 1973 وحتى 1983)، وكانت صورة حافظ الأسد فوق رؤوسنا، وليس من السهل تخيّل أن يكون قدوتك مجرماً”.
أول السؤال كان في الجامعة، درستْ في كلية الإقتصاد، “حيث كانت ندوة الثلاثاء الاقتصادي، وكان عارف دليلة، الأستاذ الذي أشعل ضوءاً في عقل كل طالب”، كما تقول اسكندر، وتضيف “هناك، في حوارات الجامعة، قيل لي إنك تدافعين عن مجرم، وحينها ذكر أمامي تل الزعتر. عدت إلى أرشيف أبي. الرجل الذي أثق به، والذي كانت صورته معلّقة في صالون البيت على الدوام، وفي واحدة من مقالاته وجدته يقول إنهم كانوا على خطإ في تل الزعتر”.
وتضيف ” بعدها، عندما عملت في وزارة الخارجية، عرفت أكثر معنى هذا النظام، حيث تجد أن الإضرار ممنهج، وتجد نفسك أمام خيارين، إمّا أن تعمل مع المافيات أو أن تنزوي بعيداً”.
هكذا تروي اسكندر حكايتها، وصولاً إلى بدايات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا. حينذاك، تقول اسكندر، “قررتُ، في قلب مملكة الصمت تلك، أنه إذا بدأ الحراك سأكون من ضمنه”.
إستقالتها من عملها “كانت دائماً مطروحة، لكن الأمر مخيف، فالمرء معرّض للملاحقة”، والعيون مفتوحة على أمثالها.
وتضيف “كنت أسكن في ضاحية يوسف العظمة، كان عليّ أن أمر بسيارتي يومياً عبر مفرقيْ داريا ومعضمية ولا أبالغ إن قلت إنه كان هناك كل يوم جثة جديدة، ولم يكن بالوسع إلا أن ندير عجلات سياراتنا مبتعدين”. تقول اسكندر، وتضيف “من بيتي في تلك الضاحية كنت شاهدة على مجزرتين، مجزرة جديدة الفضل، ومجزرة جديدة عرطوز في آب 2012 لقد شهدنا الجريمة وكان الدم طرياً على الأرض”.
وتغرق لمى قليلاً في الصمت، تعتذر عن بكائها، ثم تستأنف :” كنا نسكن في ضاحية الشبيحة، قريباً من بيتنا كانت تجثم راجمة صواريخ، وكنا مذعورين وأبوابنا مغلقة. في مجزرة جديدة الفضل بقينا نسمع صوت الرصاص لأربعة أيام، سمعنا كل شيء، أصوات الناس، ثم كيف جمعوا الجثث وأحرقوها. لقد شممنا روائح احتراقهم “.
“على المرء أن يكون وحشاً كي يقدر أن يستمر مع النظام”، تقول السيدة، بعبارة أرادتها حاسمة هذه المرة، كما لو أنها قرار.
الرسالة
في شهر آذار/مارس من عام 2013 ستعثر لمى اسكندر على صفحة في فيسبوك تخاطب الذين مع الثورة من الديبلوماسيين، فترسل إليهم، ومن هناك سيبدأ الترتيب لخروجها. هي التي لا تلوي على جواز سفر، ولا يمكنها التحرك إلا بإذن من وظيفتها.
تقول اسكندر ” أخيراً تم الاتفاق مع الجيش الحر أن أخرج في الخامس من حزيران/يونيو من ذلك العام، وكان الترتيب أن أصل إلى ألمانيا خلال أربع وعشرين ساعة ، ودّعتُ طفليّ ، زينة (ست سنوات)، وسالم في عمر الرضاعة، على أن يسافرا مع أبيهما زياد، الفلسطيني الذي يحمل مع الولدين جواز سفر أردنياً”.
لكن خطأً ما سيحدث، سيمدّ في عمر الرحلة سبعة أيام رهيبة تقول “خرجت لا أحمل سوى حقيبة صغيرة، ليس فيها سوى بعض وثائق وشهادات، حتى من دون حقيبة ثياب. وخلال الأسبوع لم يبق جهاز مخابرات في البلد لم يبحث عني”. وتضيف “أذكر حينها أنني اشتقت لمجرد أن أكون في ثياب النوم، وكنت أضم وأقبّل صور أطفالي التي أحتفظ بها على هاتفي المحمول”.
لا تسترسل اسكندر في الحديث عن تفاصيل الأيام السبعة، فهي تخشى أن يتعرض للأذى من قدم لها العون، فآلة القتل ما زالت ناشطة في كل مكان. (رغم أن الشكر الذي وجهته لتنسيقية القصير وريفها في بيان الإنشقاق، يشير إلى الطريق الذي سلكته). وتردف “كان صعباً عليّ، لحظة وصولي إلى ألمانيا، أن أرى طفليّ في مخيمات اللجوء. كان ذلك قاسياً، لكن مجرد اللقاء بهم أنساني كل شيء “. فالعيش العسير في ذلك المكان سيستمر لعام ونصف، الأمر الذي تعتبره اسكندر معطّلاً للإندماج في ثقافة البلد الجديد. ورغم أنها تلقت عرضاً باذخاً من دولة خليجية للإستضافة والعيش فقد فضّلت اسكندر أن تقاسي ما تقاسيه. تقول “كنت أشعر لو أنني قبلت، أن الرسالة كلها ستتبدد “.
القتل في الشوارع
الأمر نفسه جعلها تتخلى عن خيار الخروج إلى باكستان، حيث صدر قرار تعيينها قنصلاً هناك (كان الانشقاق من هناك سيكون أسهل بالتأكيد)، وعن راتبها الشهري الذي سيبلغ تسعة آلاف يورو. لقد أرادت أن تجعل من نفسها رسالة. ربما كان جزءاً منها أيضاً، أنها أرادت الناس أن تطمئن لـ الجيش الحر ، هؤلاء الذين تقول عنهم “كانوا آنذاك شباناً تركوا جامعاتهم، رايحين للموت، ولا أستطيع إلا أن أكنّ لهم كل الإحترام والإمتنان”.
بعد وصولها أرسلت اسكندر بيان انشقاقها لقناة الجزيرة، تقول ” حرصت أن أخبرهم أنني أول ديبلوماسية تنشق من دمشق، وأنني ابنة الوزير أحمد اسكندر أحمد. أردت أن أبعث برسالة للخائفين من الديبلوماسيين، والمشكّكين بالثورة ويعتبرونها طائفية. أردت أن أقول أيضاً، إنني امرأة، وعلوية، وفي هذا الموقع. كانت رسالتي للجميع، عائلتي، زملائي، أصدقائي، وللطائفة، أن هناك ثورة، وهناك مجازر، ولا يجب الوقوف إلى جانب المجرم “.
وهنا تفسر اسكندر علويتها فتقول :”كانت تلك المرة الوحيدة التي شعرت فيها بأنني يجب أن أقول إنني علوية، لأن ذلك معنى ورسالة، ولكن لم أقبل تالياً (بل وأستغرب) أن يجري التعامل معي كعلوية “.
عند سؤالها كيف كان الصدى، العائلي خصوصاً، تقول “لم تكن هناك مفاجأة، فالعلاقة أساساً متأزمة، لكن كان هناك كثير من الدموع “.
في بيان انشقاقها المؤثر، إلى اليوم، ككل بيانات الانشقاق الممتلئة بالكرامة والرفض والضمير الصاحي، قد يصمد المرء أمام كل ما قيل عن الإرهاب الأسدي وفظاعة المجزرة، غير أن تلك العبارة في البيان ستظل تحمل دويّاً إستثنائياً لا يرحم : ” إننا نُقتل في الشوارع “.
لمى أحمد اسكندر تعيش اليوم في ألمانيا ، متدربة في برلمان ولاية براندبيرغ، كمرجع سياسي سوري في مكتب رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان. ولا تعمل ضمن أي إطار سياسي سوري. تقول إنها سعيدة بأن توصل رسالة سوريا التي تتمناها.
وتقول “دعيت إلى جنيف2 ولم أذهب، وعند سؤالها كيف تعلّق على المجلس الإستشاري النسائي، الذي شكّله المبعوث الدولي إلى سوريا، تجيب “حين يجري الحديث عن آثار تدمر قبل نساء تدمر، سأشكّك بمصداقيتهن. حياة طفل هناك على قمة الأولويات. يجب أن نحكي عن تدمر وكيف سلمها النظام لـ داعش، عن ثمانية آلاف معتقلة في سجون النظام، عن التطهير العرقي، عن الشبيحة واغتصاب النساء في أحياء حمص المعارضة “.
المصدر ـ القدس العربي