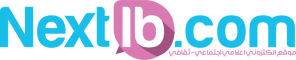في شهر حزيران ١٩٨٠ وقبل سنةٍ من انتهاء ولايته قام الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وهو اليوم في التاسعة والتسعين من عمره، بزيارةٍ إلى الفاتيكان حيث قابل البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. وفور دخوله إلى مكتب البابا، وكانت حروب لبنان مشتعلة ومقلقة، سأله هذا الأخير فورًا: “هل بالمستطاع التفكير بتوسيع انتشار قوّات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان بحيث تتواجد على مجمل الحدود الأخرى وتحمي لبنان كلّه؟” فأجاب الرئيس الأميركي بالنفي. إذ ذاك قال له البابا تفضّل بالجلوس وانتقل معه بالحديث إلى المواضيع الأخرى مكتفيًا بتوصيته بالاهتمام بلبنان. ومن ثم واستنادًا إلى هذه التجربة وغيرها في مجال انشغاله الشديد بلبنان أخذ البابا على عاتقه هو الاهتمام بهذا البلد الصغير في الشرق الذي وصفه لاحقًا بأنه أكثر من وطن وأنه رسالة إلى الشرق وإلى الغرب بعد ذلك وقبل عقد السينودس من أجل لبنان الذي ترأسه في العام ١٩٩٥ وزيارته إلى لبنان في أيار ١٩٩٧ ونشره وثيقة الإرشاد الرسولي.
لبنان رسالة إلى الغرب قبل الشرق وفق توصيف البابا، أم هو مرتبط بحروب الآخرين مرتبطٌ بغزة وبقضية فلسطين التي دفع ثمنها أكثر من غيره بكثيرٍ ولا يزال.
من الغرابة أن الموضوع إياه لا يزال مطروحًا على الحدود كلّها جنوبًا وشرقًا من المواجهة في الجنوب مع إسرائيل إلى مشكلة النازحين عبر الحدود المستباحة للبشر وللتهريب على أنواعه.
كيف تحمى هذه التجربة. كيف يُحمى لبنان من داخلٍ ومن خارج.
خُلق لبنان لكي يكون حرًّا. لا آسرًا ولا مأسورًا. كان ذلك قدره منذ البدء، والبدء ليس تاريخ الأمس. إنه لم يولد على موائد الكبار، ومساحته لم تحدّد بخرائط موفدي الدول. ليست أرضه وقف الله كما يقول بذلك بعض الغلاة، ولا هي أعدّت لكي تزنّر بالصواريخ.
ذنبه، وهو ذنبٌ لا يُغتفر، أنه وُلد في الشرق، في شرقٍ كان ولا يزال معقّدًا، لسببٍ جوهري أنه لم يعرف الحرّية يومًا، تلك الحرّية التي كانت ولا تزال مبرّر وجود لبنان. ولعل أول من أدرك كُنهَ لبنان وسرّه العميق هو أحد عظماء القرن العشرين، الجنرال شارل ديغول الذي قال عام ١٩٤١ في زيارته الثانية إلى لبنان: “صوب هذا الشرق المعقّد أنا أجيء بأفكارٍ واضحة”. إنه دخل الشرق من البوابة اللبنانية كما يُفترض بكلّ باحثٍ عنه، من بيروت سيدة المتوسّط من دون منازع بالأمس كما اليوم، وأقام في شارع مار الياس في بيروت، ونظر إلى الشرق من خلال تلك الرؤية التي لا تستقيم إلّا من بيروت. حدث ذلك بعقودٍ طويلة، قبل أن يُضرب مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ بجريمةٍ كان الإصرار عليها أن تبقى غامضة. وأن يُجمد ملف التحقيق فيها لمصالح من هنا ومن هناك.
كان الشرق معقّدًا ولا يزال. لم تعرف أنظمته الحرّية، بما فيها ذلك الكيان الطارئ عام ١٩٤٨، الكيان الإسرائيلي الذي لا يمكنه أن يكون حرًّا ما دام أنه عنصري. وهذا يكفي ليدحض مقولته أمام العالم بأنه نظام حرّ. إذ ما من حرّية في بلدان التمييز العنصري والذي قام على أساس أنه: “يحق لكلّ يهودي في العالم أن يأتي إلى إسرائيل بصفته مواطن عائد” وفقَ ما نص عليه قانون العودة فيها في تموز١٩٥٠. فيا للعجب! عائد من أين؟ من غياهب الدهر. من تاريخ تدمير هيكل سليمان عام ٧٠ ميلادية. فها هي المملكة المتّحدة ترفع إلى سدّة المسؤولية الحكومية فيها رجل من أصل هندي. كما فعلت الولايات المتّحدة من قبل عندما انتخبت باراك أوباما وهو من أصلٍ غاني. فهل يمكن أن يصل إلى سدّة المسؤوليات في إسرائيل رجل غير يهودي؟ بعد ذلك يمكن أن نتحدّث عن الحرّية فيها.
بقيَ لبنان وحده. بلد الآخر. بلد الرحابة، بلد الخصوصيات المحترمة، إذ لم يسمع الكثيرون ربما بحملة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا ولي مصر مطلع ثلاثينات القرن التاسع عشر إلى لبنان وتعيينه مجلس بلدية بيروت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وذلك قبل اتفاق الطائف بمائة وستة وخمسين عامًا. والذي تبعه شكيب أفندي وزير الخارجية العثماني الذي حضر إلى لبنان عام ١٨٤٥ وأقام مجالس البلدية فيه على أساس تمثيل الطوائف الست، مناصفةً كما جرى بعد ذلك في تكوين مجلس الإدارة في نظام المتصرّفية عام ١٨٦١.
حدث ذلك في أواسط القرن التاسع عشر. والدهر نقل خُطاه على ما رسم. وما كان تمّ رسمه يرجع إلى القرن السابع عشر. فأين كان الآخرون في هذا الشرق يومذاك؟ لم يصدر أي ظلمٍ من لبنان على أحد. والقرارات الدولية كلها المتعلقة به، منذ البدء وحتى الأمس القريب بالقرار ١٧٠١ في آب ٢٠٠٦ كلها تُنصفه. كونه لم يُخلق للإيذاء لا من داخل ولا من خارج. بلا، لعله تسبب بإيذاء ممارسة الحّرية، يوم ارتُهنت بعض صحافته أيام كان المشهد الإعلامي محصورًا بالصحافة المكتوبة، لأنظمة عربية متصارعة. فتعب لبنان وامتدت الأيدي الغاضبة لتُصفي حساباتها مع بعض الصحافيين من كامل مروة عام ١٩٦٦ إلى ادوار صعب ١٩٧٦ إلى سليم اللوزي ١٩٨٠ إلى رياض طه ١٩٨٠… إلى سمير قصير ٢٠٠٥ ثم إلى جبران تويني في ١٢ كانون الأول ٢٠٠٥. وذلك لحاقًا بقافلة شهداء أيار ١٩١٦ من الصحافيين: الشيخ أحمد حسن طبارة، وسعيد فاضل عقل وعبد الغني العريسي والأمير عارف شهاب وبترو باولي ثم الصحافيان الشقيقان فيليب وفريد الخازن صاحبا جريدة الأرز. وصولًا إلى نسيب المتني وفؤاد حدّاد “أبو الحن” في نهاية الخمسينات.
الدروس الدموية تلك لم تفد أصحابها بشيء، بالرغم من تبدل أصحاب الأمر بذلك من الزمن العثماني إلى اليوم. وشهداء الرابع عشر من آذار لا يزالون أحياءً في ضمائر المخلصين. حاول الحكم في لبنان معالجة موضوع الصحافة بالقانون الصادر عام ١٩٦٦ والذي أُطلق عليه “قانون الملوك والرؤساء” الذي حظّر على الصحافة اللبنانية التعرّض للملوك والرؤساء العرب. ولكن أين ذلك القانون من الحريات ككلّ. حرّية الكتابة أي حرّية التعبير كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من مجمل الحرّيات العامة أو ما يُعرف بالحرّيات العامة، وأولها حرّية المعتقد. ذلك حصل في لبنان رسميًا ودستوريًا منذ العام ١٩٢٦ “حرّية الاعتقاد مطلقة”. وبعد ذلك لا ضرورة لأي قيد.
لأنه من الحريات هذه استباح البعض مساحة لبنان الحرّة وجعلوها ساحةً في ذلك التعبير المذّل. ومسؤولية الحكام هنا كبيرة مسؤولية عدم معرفة حماية المساحة المميّزة والحؤول دون مدّ الأيدي إليها ودون مدّ الأيدي منها. هذه مسؤولية اللبنانيين، وتحديدًا مسؤولية من استقوى بالخارج ولا يزال. لأن ما جرى ويجري هذه الأيام من خلال ربط لبنان بحرب قطاع غزة هو عملية شديدة الوضوح لربط لبنان بحروب فلسطين. هنا لا بد من توضيح المسؤوليات.
الأوطان تسيّج مثل البيوت. وقديمًا كان للمدن أسوارًا تحميها. والمثال الشاهد الباقي على ذلك هو سور الصين العظيم.
لكن عالم اليوم لم يعد عالم الانغلاق، وها هي أوروبا تُعطي تأشيرة واحدة لكلّ مواطني دولها الثمانية والعشرين. وما كان محظورًا صار مسموحًا به مع وسائل التواصل التي حوّلت العالم إلى قريةٍ كبيرة.
نظرةٌ واحدة على كل دول الشرق، والشرق الأوسط تحديدًا تُعطي البرهان: المعترضون في السجون أو على المشانق أو في غياهب المجهول. ليس هنالك من بلدٍ يتمتع بحرية التعبير.
وحده لبنان. لبنان وحده. لن يتمكن أحد من حكمه بمعزلٍ عن الآخر أو على حساب الآخر. وإذا حدث ذلك فلزمنٍ قصير. أما حدوده، وحتى لا نبقى في النظريات المجردة، فإنها من مسؤوليات الحكام الذين تعاقبوا وأباحوا المسَّ بالمقدسات لأن السيادة مقدسة. واتفاق القاهرة كان مسًّا بالسيادة وكذلك ملحقاته. وحماية السيادة بمفهومها الداخلي والخارجي هي الهمّ الأول، وعليها يُقسم رئيس البلاد قسمه المعروف، وهو الوحيد الذي يُقسم اليمين في الجمهورية: “وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”.
ولكن في غياب الكبار، وهي أزمة لبنان الأولى أولًا وآخرًا، تبقى الحرّية التي لا يمكن لأحدٍ أن يأخُذها أو أن يمسَّ بها. لأنها هي الأساس، وهي السور العظيم الذي لا يتزعزع.
الدكتور داود الصايغ
المصدر النهار