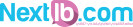“خُلِقتُ لأكونَ نحاتاً” عبارة يرددها الفنان السوري النحات مصطفى علي، على مسامع زوار معرضه الاستعادي المصغّر الذي يقام في غاليري Mission art في بيروت (مار مخايل – شارع أرمينيا – حتى 18 فبراير)، ويضم مختارات من الأعمال النحتية التي تعود إلى نتاج عشرين عاماً خلت، احتفاءً بتلك الذاكرة البصرية المليئة بالتجارب والمعاناة والتأسيس والسفر والارتحال، بعيداً من معاناة الحرب وتداعياتها المأساوية التي قضت على محترفه في الغوطة.
فهو منذ عام 2010 مقيم بين محترفه الباريسيّ (في التروكاديرو) ومحترفه الذي يحمل اسمه في حارة اليهود في دمشق القديمة، الذي رمّمه بما يتوافق مع تراث البيوت الشامية، وهو كائن بين البيوت المهجورة التي غادرها أصحابها من اليهود السوريين تباعاً إلى فلسطين وأميركا منذ الخمسينات والستينات من القرن الفائت، فيما تحولت بعض تلك البيوت مع بداية الألفية الثالثة إلى محترفات للنحت والرسم والتصوير والإقامات الإبداعية في ما بات يُعرف اليوم بـ”حارة الرسامين”.
أعماله مقتناة من متاحف عربية عدة، كما أنه حائز الجائزة البرونزية لبينالي الشارقة والذهبية لبينالي اللاذقية، فضلاً عن الجائزة التي نالها من معهد العالم العربي في باريس عام 2008، الذي اقتنى منه جدارية ضخمة لتزين سقف المعهد، تبلغ مساحتها الأفقية قرابة 36 متراً مربعاً، وتزن قرابة خمسة أطنان من الحديد المصبوب “فونت”، وتروي منمنماتها الـ36 حكايات من التراث العربي عبر إشارات ورموز طوطمية شرقية بأسلوب حديث، تجسد مواضيع مثل الحظ والقدر والمصير والخلود وعلاقة الأرض بالسماء.
ليس بالحب وحده
الوقوف أمام منحوتات مصطفى علي، يحيل إلى فن يسبح في النور بين الطقوس والشعائر والعذابات الإنسانية بأغوارها واندفاعاتها القصوى نحو المجهول.
ولا بد أن يخالجك ذلك الشعور بالقوة والرهبة والاحترام للقيمة العالية التي تنطوي عليها موهبة هذا الفنان الذي كابد طوال حياته ليستحق لقب نحّات من صنف المبدعين الكبار من نحاتي حقبة الحداثة العربية وما بعدها.
هذه المكابدة بدأت منذ سني الطفولة، في مناخ متقشف وفقير غير أنه غني بالإلهامات، التي شهدت على الوعي الفني الأول للّعب بالطين والصلصال في محيط البيت العائلي ما بين المرج وضفة النهر، لتكبر تلك الموهبة بين أضلاع مدينته القديمة أوغاريت (أو رأس شمرا في محافظة اللاذقية – مسقط رأسه – من مواليد عام 1956) عاصمة الفن الفينيقي.
هذا الفن الذي خرج من معينه الى العالم تأثيرات النبض الداخلي للإنسان بحضوره الضامر والساكن والممشوق والمتنقّل، الذي ترك دون أن يدري بصماته البصرية على ذاكرته لاحقاً حين اكتشف أعمال النحات السويسري الوجودي ألبرتو جياكوميتي (1901- 1966).
ليس الحب وحده هو الذي صنع لموهبة مصطفى علي لمعاناتها المضيئة، بل الثقافة الفنية التي تشربها من ينابيع تراثه المتوسطيّ، والخبرة والتجارب التي اكتسبها في إيطاليا حيث درس الفن لا سيما في موطن مقالع الرخام في كرارا، وقوة الانغماس في صناعة الجمال الإنساني في حالات الحضور والغياب (مؤثرات الفنون الكلاسيكية القديمة والفن الاتروسكي) ليتوغل أكثر في اكتشاف البعد الوجودي للإنسان من منحى تعبيري حديث، متأثراً بالهيئات الشبحية الغامضة الكامنة في الحضور الموميائي الفرعوني والتماثيل البرونزية في حضارة الفينيقيين ووادي الرافدين.
لا يجدُ مصطفى علي في التاريخ القديم سوى الإنسان في بحثه عن الخلود، الإنسان قديماً كما هو حاضراً، يراه مجبولاً بالمرارة والعذاب والصراع من أجل البقاء.
الحرب التي اندلعت في سوريا دفعته إلى تجسيد صراخه ضد العنف والقتل، منجزاً اعمالاً ضخمة بمادة الخشب بنبرة واقعية لا مثيل لها في النحت، تمثلت في تيمة “الساطور”، من دون أن يستبعد من تجاربه في المعادن (الكروم والحديد)، فضلاً عن استخدام المخلّفات من مدمَّرات الحرب. فكأنما الحرب رسخت انتباهه المقصلة أكثر نحو فكرة الموت كرحلة نحو الخلود أكثر من ذي قبل.
لذا كثيراً ما يتحدث عن “فن الموت” الذي يراه ماثلاً في النحت التدمري في الحضارة السورية القديمة، القائم على التجسيد الجنائزي للأضرحة والنعوش وتخليد الوجود الإنسانيّ بمؤداه الحياتيّ كذكرى للمتع الدنيوية الفانية أو كشكل من أشكال مقاومة الموت عبر الفن.

وقفة الزمن
ثمة ما بين الروح والجسد، يثوي في علاقة تآخي الخشب بالبرونز، كالعلاقة بين اللحم والعظم في جسد الإنسان (بحسب تعبير الفنان)، أو كالعلاقة بين هوية الإنسان ودلالات المكان الذي اندثر وأصبح إطاراً أو هيكلاً أو منصة أو بوابة نحو الفضاء، كما لو أن الفضاء شكلٌ من اشكال الماضي. هكذا تقف شخوص النحات علي، داخل هياكل أو عتبات مفتوحة على المطلق، أو تبدو مستقلة في حركة الزمن، كي يصل الاشتغال على هذا التوليف بين الخشب القديم والبرونز إلى ذروة الخيال والى صدمة اللامتوقع، في أعمال تنصيبية ذات تآليف أفقية أو عمودية، لتيمات هي بين الاستلقاء والعوم والخروج من أسر المادة وحالات القمع والخوف الى الحرية. تتشكل القامات البرونزية كجزء لا يتجزأ من أعمار تلك الجذوع الخشبية المتشققة أو تتبدى كمومياءات داخل تكاوين خشبية، شبيهة بالصناديق المدفنية التي تعتليها حيوانات أسطورية (أنوبيس) متصلة بالروح والحياة الأخروية (على غرار صناديق المدافن الملكية الفرعونية).
ثمة وقفات تذكارية محورها الإنسان، لكأنها وقوف الزمن نفسه، وتيمات بين جلوس دهري أو مع الحيوان رفيقاً قديماً منذ الحضارات البدائية أو الثنائي الرجل والمرأة، تتراءى على وجه الخصوص في المنحوتات البرونزية، تشكل امتداداً ظاهرياً لتماثيل النحات العراقي اسماعيل فتّاح وتتقاطع في آن واحد مع تماثيل النحات المصري آدم حنين، على هذا التمّاس المشترك ما بين ينابيع الإلهامات المتأتية من حضارات الشرق القديم وعلاقته بموحيات حداثة الغرب في أوروبا.
لكن لدى مصطفى علي، ذلك التميّز في النفس التعبيريّ – الدراميّ الذي يتبدى في طريقة تشكيل المواقف الخطرة للحياة المدفوعة بالعنف إلى آخر العتبات.
في هذا المعنى، يذهب التشخيص إلى أعمق مداه في التعبير عن قوة الاندفاع المتمثل بالحركة العضلية التي تتراءى في الجسد المشدود بعنف وهو في حال المقاومة.
يتمثل ذلك على نحو نموذجي في منحوتة الرجل المطعون في جسده وهو يستغيث ممسكاً الهواء بيديه المشرئبتين قبل السقطة – الفاجعة. لنا أن نتخيل الضغط النفسي والجسدي الهائل لحركة آخر رمق من الحياة، لآخر نظرة وآخر دمعة.
في المعرض عشرات المنحوتات الخشبية وهي رؤوس آدمية متطاولة وكروية ضخمة متصدعة أحياناً بلا ملامح محددة.
وجوه ساكنة كأنَّها مُنتَزَعة من عالم القمع، تعكس حال ذهول أو لامبالاة تخبئ قلقاً وجودياً، تنتصب واقفة كأنها معلقة في الأرض متجذرة في الشقاء والبؤس.
حفرٌ وتنقيب في أعماق هذه الكائنات، لكشف عوالمها وذواتها الخفية، صمتها وهذيانها على نحو ما يظهر في منحوتة بعنوان “الرجال الجوف” أو الخاوون، التي إستوحاها مصطفى علي من قصيدة بالعنوان ذاته للشاعر ت. س. إليوت (1888-1965)، تتحدث عن الأرواح المحطمة والفاسدة والعابرة نحو الموت الآخر، كما تبحث عن معنى الخواء، حيث الفراغ يغور داخل الجسد، بما يوحي بفقدان الإنسان لمحتواه الفكري والعاطفي ليصبح قلباً بلا روح، شبحاً بلا لون، مثل خوذة محشوة بالتبن، مثل أصوات مجففة، أو ريح في عشب يابس.
المصدر: النهار العربي
مهى سلطان