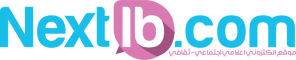رحل حسين ماضي (1938- 2024)، أحد كبار فناني الحداثة التشكيلية في لبنان عن عمر يناهر الـ85 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً لا يعد ولا يحصى من الأعمال الموزعة في أنحاء العالم.
رحل عاشقٌ الحياة بألوانها وزخارفها ولهوها ومتاعها. هو الملقب بـ”بيكاسو الشرق”، ليس عن عبث، بل عن مزايا مشتركة تتمثل بعصبية المزاج وحدّة الذكاء والعبقرية، عدا الشهوة العارمة للمرأة والولع بالطبيعة والطيور والافتتان بعالم الأشياء التي يفككها ويحللها ويقرأها على أنها نظام أشكال تهبها الطبيعة الكونية.
ليس سراً أن ماضي كان يتعمّد أن يظهر بمظهره أحياناً، خصوصاً حين كان يرتدي “التيشرت” القطنية المقلّمة التي عُرف بها بيكاسو مع انتشار الصور التذكارية له في أواخر سني حياته.
إنها الطبيعة التي تَعلّمَ منها كيف يُبصر وكيف يُجرّد بقوله: “أنا لا أرى بل أقرأ”، ينطلي عليه قول بيكاسو “أنا لا أفتش بل أجد”. باعثٌ على الحيرة والتساؤل في دمجه بين قوام “التكعيبية” بسطوحها ذات الانكسارات الحادة القائمة على المثلثات والمكعبات، وبين الفلسفة الجمالية للزخرفة في الفنون الإسلامية. علماً أنه من القواعد الرياضية لتلك الفلسفة رأى موندريان Mondrian الطبيعة على أنها خطوط أفقية وخطوط عمودية، فقاد العالم نحو التجريد، أما حسين ماضي فقد رأى الطبيعة أنها “قوسٌ ووَتَر”، ليحتفظ بمذاق الحياة وحلاوتها وبهجتها فيُجَرّدها أو يُشخّصها على هواه.
فالطبيعة هي بمثابة قاموس أشكال Form غنيّ، وهي في نظره ليست قوام اللغة الفنية فحسب بل أبجديتها المستمدة من نظامها الموجود أساساً في تكوينها الهندسي. لذلك فهو حين يرسم الطيور والأوراق والثمار والنساء والثيران والأحصنة والديوك… ، يبوح بحقائق جمالية نابعة من أسرار قراءته للأشكال وتأملاته لها على أنها أحجامٌ ونِسبٌ وألوانٌ ومسافات منها القريب ومنها البعيد. وتزداد لغته تبسيطاً كلما جرّد الأشياء من وظائفيتها في الواقع ليختزل وجودها بألوان حارة وخطوط وسطوح هندسية متفارقة.
العين تشتهي مذاق اللون
لعلّ ماضي هو من أكثر فناني جيله تجدداً وإنتاجاً وغزارة واختباراً. ليس ذلك من قبيل المبالغة، خصوصاً أن عدد معارضه قد تخطى بأشواط سني حياته التي أمضاها في العمل يومياً.
هو يهرب من الوقت إلى العمل ومن الفراغ المحيط بحياته إلى فراغ اللوحة التي تفتح له ذراعيها كي يكون بطلها الأوحد. فهو رسام ونحات وحفّار ومصمم أشكال، لا يرى عمله على مُسندٍ واحد بل لطالما سعى لتطبيقه على مختلف الخامات والمواد وأنواع المعادن، فقد كان يرى أن تيماته يمكن أن تتلبس أي مادة أو أي خامة أو أي فضاء.
ابن بلدة شبعا القرية الجنوبية الواقعة على الشريط الحدودي التي فتحت مداركه على جمال الطبيعة وحب الأرض، ولأن والده كان يعمل في سلك الدرك، لذا عاش قسطاً من طفولته في مدينة طرابلس التي نادت عينيه إلى زرقة البحر ورغبة السفر. وكأن القدر اختاره ليكون فناناً، منذ بداياته التي أمضاها في إيطاليا (منذ عام 1963) في أكاديمية الفنون الجميلة في روما، متنقلاً بين المتاحف التي تضم روائع كبار النهضويين الإيطاليين وبين المحترفات الفنية الحديثة التي تلقَّنَ فيها تقنيات النحت والحفر والموزاييك. ظل ماضي في روما مقيماً وعارضاً أعماله هناك، دون أن ينقطع عن بيروت طوال فترة سبعينات القرن العشرين وثمانينياته.
مَنْ لم يرَ كيف كان يعيش حسين ماضي، داخل منزله في روما، لا يعرف شيئاً كثيراً عن فنّه. قد رأيتُ رأي العين كيف فَرَش عالمه الداخلي وحجرات البيت بمفرداته وزخارفه وطيوره وكائناته، التي رسمها على الجدران وطبعها على أقمشة الأرائك والوسائد والثريات والستائر، بعاطفة من يريد أن يُخرج عالمه من أَسْر اللوحة إلى فضاء العيش، وأن يحيط نفسه بجمال يبوح بأسرار خلوته. فهو يدلِّل نفسه حين يزّين حياته بإبداعات من صنيعه، ما يُشعره بالراحة والحبور والسلام الداخلي، خصوصاً أن نافذة بيته كانت تطلّ على قبة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان قريباً من مجرى نهر التيبر. لم أعرف شغفاً يوازي شغف حسين ماضي في تزيين الأمكنة التي يعيش فيها ويرتب محتوياتها بنظام ويجمّلها بمفردات من زخارفه الشرقية، إلا شغف هنري ماتيس الذي حوّل منزله في نيس إلى متحف حيّ، كي تعوم على جدرانه النباتات البحرية والاستوائية وترقص على عقوده النساء الزرقاوات. فالهوس بالزخارف الإسلامية كان عشق ماتيس، والزخرف لماضي هو الفن كله، أنّى تجلّى، سواء في التجريد أو التشخيص، لكأنه زينة الحياة الدنيا، ولغة الترداد في التطريب البصري الشبيه بالتطريب في الموسيقى العربية التي يعشقها حسين ماضي، لا سيما بأدوار صوت صالح عبد الحيّ. فهو لم يزيّن الأمكنة التي عاش فيها فحسب، بل كان يزيّن أيضاً طبق الطعام الذي يريد أن يأكل منه فتشتهيه العين قبل الفم.
إنها العين التي تشتهي مذاق اللون، واللون لدى ماضي كثيفٌ مثل غمرٍ عالٍ نابع من العين والقلب معاً، تَراه آتياً من مقامات موسيقية وأطوار و”تونات” من البارد والحار ومن الغريب المدهش. في أحد حواراتي مع حسين ماضي قال لي: “أكونُ في حالة تفتيش عن اللون، أحياناً يتم ذلك بسهولة، ومراراً أستغرق وقتاً طويلاً، عندها أمرّ بألوان عديدة لا تلبث أن تطغى على تفكيري، سرعان ما تدخل لوحتي من فرط ما تثيره من إغراء بصري. لديّ إعجاب ومحبة للوّن إلى درجة لو أن يؤكل لأكلته”.
مقام المرأة في حياته وفنه
ثمة نساء ونساء في حياة حسين ماضي، بعضهن مررن مروراً عابراً في حياته وأخريات ساهمن في إطلاق تجاربه على أوسع نطاق. كانت الشاعرة سامية توتنجي (ابنة الروائي توفيق يوسف عوّاد)، أول سيدة لعبت دوراً كبيراً في إطلاق تجاربه منذ أواخر سبعينات القرن العشرين، من خلال المعارض التي أقامتها له في منزلها الكائن في منطقة المتحف في بيروت، أما الأخيرة فكانت السيدة عايدة شرفان التي أفردت لأعماله الكثير من المعارض والإطلالات قرابة ثلاثة عقود من الزمن في الغاليري التي حملت اسمها (في أنطلياس وفي وسط بيروت)، وما بينهما عمرٌ من التجارب والنجاحات التي حققها في المعارض المحلية والعربية والدولية والاقتناءات المتحفية لأعماله. ورغم أن ماضي عاش وحيداً لكنه أحاط نفسه بنسائه اللواتي رسمهن لكي يملأن حياته بالحب والشغف دون متاعب تذكر، حتى لا يثنيه شيء عن الفن.
في رجعته القوية إلى التشخيص منذ سنوات خلت، أخذت تعود إلى فن ماضي ذاكرة عينيه المصحوبة بشهوة الألوان القوية أكثر من ذي قبل، كالعودة الجامحة إلى التعبير عن الواقع بنزوة من يرغب أن يكون للحياة اليومية مكانة في فنه وبصيرته. جاء ذلك كمصالحة ما بين قديمه التشكيلي الذي يسترده مراراً وتكراراً، وجديده الذي يشبهه أكثر من أي وقت مضى. وهي مصالحة أيضاً بين ما يراه ويتخيله، وبين الفكرة وتحولاتها غير المتوقعة. فهو يأنس للتشبيهي والتجريدي في آن واحد دونما تناقض، لكأنه يتجدد من داخل عناصره الأليفة. فالتجريد يتراءى أحياناً في رقعة من لوحة تشبيهية.
من النساء الجالسات على الأرائك إلى الطيور وصولاً إلى الطبيعة الصامتة، إذ بإمكانه أن يُلبس أي شكل يقع تحت يده ريش العصافير. هذا الريش المُسنن الذي ينقسم على جسد الطائر أقلاماً ومثلثات كبساط شرقيّ. وتظل المرأة الملهمة الأولى والجليسة والصديقة والحبيبة، يراها الفنان بشغف المراقِب اليقظ، حين تجلس قبالته وحين تستلقي أو تسهو أو تستريح أو تضجر أو تثرثر مع أترابها في رؤية تنتمي إلى طبيعة الداخل، أو ما يُسمى بعالم الغرفة التي يوثثها ويعلق على حوائطها صوراً من لوحاته، ليقول إنه في حضرة ذاته وإن المرأة هي زائرة محترفه وهي شغفه وحبه وحبوره وهي التي تضفي على عناصره بهجة وسروراً. يصورها وهي تتغاوى، بكعبها العالي وفخذيها الممتلئتين وفستانها المزركش بأوراق الأشجار وتسريحة شعرها العصرية وغرتها المنسدلة على جبينها. وهي وسط اللوحة ومركزها، وكل ما حولها يضج مثلها بالألوان والعناصر والتفاصيل، ويعبق بأريج الأزهار وأنغام العود وفاكهة المائدة. لكأنه يوضّب الأشياء التي تدخل مسرح لوحاته، ويعتني بطرائق تموضوعها في تنسيق شبه سينوغرافي يحضر فيه الشكل واللون والإضاءة في فضاء مغلق بإحكام.
يصف حسين ماضي أشكاله وصفاً حسياً – شهوانياً ومجازياً، على دقة في الرسم والتلوين ونقاء جليّ. فهو نرجسي متملّك ومتطلب في توضيح معاني لوحاته ومضامينها. كل شيء في اللوحة يبدو مرتباً ونظيفاً، لكأن الأشياء مطبوعة بطابعه ومزاجه. فهو من النوع الذي يطغى، وذاتيته المتطرفة هي التي تمنح الأشكال وجودها وحضورها ومذاقها وشغفها. فهو غرافيكيّ في أسلوبه، هندسي في طبيعته ونظامه، اختصاريّ في تبسيطه، متطيّر في مزاجه وانفعاليّ حاد في خطوطه، واضح في تصميمه ورؤيته، شكلانيٌ وزخرفيّ، ملّون يتجرأ في المزج حتى يصل إلى مقامات لونية جديدة وغير أليفة. يمسك بالقوس والوتر، من تقابلهما تنبثق الورود لتتفتح، كما تنشأ كل التكاوين العضوية من أعطاف الذراعين إلى الصدر ثم حنايا الرأس وباقي الجسم. فأنصاف الدوائر هي مفردات لعوبة تتكرر وتتراءى في كل مكان وفي كل موضوع. لذا يتشابه في هذا المعنى شكل المرأة وحبات الرمان والتفاح وأزهار الآنية. ولئن كانت تفاحات سيزان مثار لغو التكعيبيين، فإن رمانات حسين ماضي لهي الأكثر تفرداً في هندستها بين نماذج كل ما يُرى ويؤكل على مائدة الفن.
المصدر: بيروت- النهار العربي
مهى سلطان
شريط الأخبار
- مغادرة طائرة تقل إيرانيين من لبنان باتجاه روسيا
- نتنياهو يهدد لبنان: نزع سلاح “حزب الله” أو مواجهة عواقب قاسية
- رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون: تحركوا قبل أن نتصرّف!
- دعوة من وزير الإعلام لتغطية إعلامية كثيفة للقداس على نيّة خلاص لبنان.
- الجيش اللبناني يثبّت نقطة عسكرية داخل بلدة شبعا لتعزيز الأمن في القطاع الشرقي
- قيادة الجيش وزعت إرشادات عامة للإعلاميين أثناء التغطية الإعلامية في مختلف المناطق
- الشرع يتصل بسلام: متضامنون معكم
- العدو يرتكب مجزرة في الدوير : 5 شهداء و9 جرحى