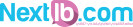عشرون عاماً مرّت على رحيل الفنان رفيق شرف (2003-2023)، كأنّها الأمس وكأنّ رفيق شرف ما زال يكتب ويسجّل ملاحظاته في المقهى ، معتمراً قبعته التي كان يُدنيها من جبهته كي يُبعد عنه عيون الشرّ وحشرية العابرين المتطفّلين.
فالفنان الذي شغل الأضواء بحضوره الأخّاذ وثقافته ومزاجه ومواقفه الجريئة وسخريته وعبثيته وتقليعاته، ها هو يغيب ذكرُه أسوةً بغالبية فناني جيله، بلا تكريم ولا تقييم، وكأننا بلا ذاكرة ولا جذور ولا تاريخ، نعيش راهن الفن فحسب وننسى ما قد سلف.
في الذكرى العشرين لرحيله (توفي في 24 كانون الثاني يناير 2003)، لم يعد بالإمكان سوى تفقّد نتاجه والعودة إلى قراءة “كتاب رفيق شرف” الذي يشبه يوميات الفنان في المقهى، بدهاليز شخصياته البوليسية وأبطاله وغرامياته، وتعقُّب مراحله وأعماله، بحثاً عن معنى السحر الكامن في حروفياته وطلاسمه وأحجبته وتعاويذه.
وإذا ما نظرتُ بعين الحنين إلى الحروفية في التجارب العربية، لقلتُ بأنّها جاءت مثل القضاء والقدر، ومهما شابها من شوائب وانقلب عليها من انقلب، فالذين دافعوا عنها من المُبرزين بعضهم ماتوا، وبعضهم استمروا على ضفاف تجاربهم أو انعطفوا إلى غير اتجاه. منهم من كانوا أنهاراً ومنهم من كانوا جداول ومنهم دون ذلك، غير أنّه لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أن نستذكر ما يحلو لي أن أسمّيه أجمل اليقظات أو أجمل لفحات الحب واللفتات نحو التراث، التي ربما لن نشهد لها مثيلاً في عصرنا الراهن عصر العولمة بامتياز.
التراث كمعطى حداثي
مؤسّس من جيل الحداثة مدافع عن الهوية العربية، هو رفيق شرف الرسام البعلبكي الأصل والطفولة والانتماء، والبيروتي الإقامة والوجد والاختبار. عرفت بيروت تحوّلات فنّه ومشاكساته الثقافية في كتاباته وجلساته في مقاهيها. فنان المراحل والمتناقضات الصعبة.
ثائرٌ على التقاليد، متجذّرٌ في الأرض، عاشقٌ للحياة والحرّية. أحياناً هو الفارس الآتي من صدر الحكاية وأشواقها وحنينها، ومراراً هو الحصان الذي يسابق الريح، لكنه بالتأكيد هو الطائر الطليق الذي عاش وحيداً على هواه بجناحيه الكاسرين، يجوب سهول بعلبك (مسقط رأسه) من أقصى رباها إلى آخر ضبابها.
عبثيّ قدريّ ساخر، له فلسفته الخاصة في الحياة والفن، مشاكس وجريء ذو شخصية استفزازية واستقطابية قلّ نظيرها في الفن اللبناني والعربي. فأعماله ليست إلاّ مرايا لمحطات حياته وتساؤلاته التي كانت تصبّ في جوهر الطروحات التشكيلية العربية، وفي بحثها عن التراث الضائع وفعالية إسهامه في بلورة الفن الحديث.
على الرغم من أنّ سعيد أ. عقل كان أول الداعين إلى استلهام التراث الحروفي- الأرابسكي، ليتأتى من بعده جماعة التجمّع الشرقي (ستيليو سكامنغا، منير نجم، وعادل الصغير)، ولكن الصرخة المدوّية انبثقت من المنشور السرّي الذي أصدره رفيق شرف عقب هزيمة حزيران (يونيو) العام 1967 ، وجاء فيه: “قولوا للتاريخ أن لا يتمزّق، لأنّ الفضاء المقدّس الذي سيأتي منه البطل في بيت شعبي، في أقصى حالاتنا اختناقاً. لا يستطيع أحد التنفس بلا تاريخ. لا قيمة عالمية لفن بلا وطن أو قومية أو روح… إنني بالضبط أرفض فن الغرب لأنّه لا يخاطبني. ونحن علينا أن نعي مدارنا التاريخي في لحظة تأرجحنا العظيمة. إنني أمسح الغبار عن وشم ساحر موجود في روح إنساننا، الإنسان الشعبي الفارس الشجاع العادل المنتصر الذي لا ينام على ضيم في زمن سمّته المجلجلة الانكسار! إنّ فننا يعاني مأزقه الجمالي وتشرّده التعس. وهو كإنساننا بحاجة إلى روحه الحقيقية”.
هكذا جاهر رفيق شرف بأزمة الفن العربي، حين دعا إلى اكتشاف مخزون التراث الشعبي منقلباً ولو في الظاهر (الانفعالي) على مفاهيم الجمالية الغربية. “إذ رأى أنّ الغرب يصنع أسطورته الآلية الحديثة، لينسج عزلته وحطامه حتى أمسى فاقداً التحريض الروحي والطبيعي والبدائي، بكل ما تحمله البدائية من إبداع وصدق وتلقائية، معتبراً أنّ الفنان الذي لا يصادق روحه ليس قادراً على أن يفهم عصره وزمنه وهو فاقد لأسطورته”.
من بعلبك- الذاكرة إلى أحزمة البؤس
طالما أنّ هناك بيتاً عتيقاً في بعلبك، ستظلّ رسوم رفيق شرف حكايات جدرانه”، تلك الجدران التي شكّلت السيرة الأولى لذلك الطفل الأرعن الشرس بحلّته الشقراء الذي ملأ جدران المدينة وطرقاتها برسومه الفحمية، لذا لازمت بدايته الفنية الألوان الرمادية والدخان الأسود وألوان الصلد والحديد المطروق وجمرات النار التي اعتاد رفيق رؤيتها في مشغل والده الحاج حسين شرف الذي كان يعمل حدّاداً وموظفاً في مصلحة الآثار.
ولد رفيق شرف في بعلبك (العام 1932) في بيت ريفي متواضع يقع في حي الريش الغربي قرب سرايا بعلبك. تفتّحت أحلامه في الطبيعة التي نهل من مفرداتها واختزنت ريشته عصارة ألوانها، حتى باتت جزءاً من كينونته.
كان أول حَدَث في حياته نزوله إلى بيروت، منتقلاً من تأمّلات الطبيعة البرية والبيئة المتموجة بالبطولات والمآسي، إلى مدينة وصفها بأنّها بلا قلب وبلا صديق وأنّها غابة وحوش، غير أنّ نظرته لبيروت بدأت تتغيّر أثناء دراسته في الأكاديمية اللبنانية (محترف فرناندو مانيتي وقيصر الجميّل) ومشاركته في معارض صالوني الخريف والربيع في الأونيسكو (العام 1953). بدأ شرف يختلط بالمثقفين ليكتشف وجه بيروت الخلاّق والمشرق (المعارض والندوات والمقاهي- لاسيما مقهى الروكسي).
ومن ثم توجّه عام 1953 إلى اسبانيا لمتابعة تحصيله الفني في أكاديمية سان فرناندو في مدريد حتى عام 1957، ومن بعدها في أكاديمية بيترو فانوتشي في ايطاليا عام 1960.
لدى عودته في أوائل الستينات، ظهرت المرحلة التعبيرية أو الرمادية، كثورة حقيقية على الجماليات التقليدية (1960- 1968) وسادت لديه مخاطبة رمزية حميمة وانفعالية حادّة، تعبّر عن القنوط في الوجه الإنساني والطيور المصطرعة بالأسلاك الشائكة وخرائب المدن وفواجعها، بأسلوب يدنو من لغة بيكاسو وتشويهاته وقسوة خطوطه، حيث السواد يحتل مكانته في تفخيم المأساة.
استطاع شرف أن يتبوّأ مكانته الخاصة في صالونات بيروت ومعارضها، وأن يطرح نفسه كفنان منتمٍ بامتياز إلى رعيل الحداثة التشكيلية.
كان رفيق شرف يسكن في عليّة من منطقة برج حمود ويعيش على تماس مع تقاليد النخبة البورجوازية الشغوفة بالفن.
وحين شعر بيباس روحه في مجتمع يعيش هوة تناقضاته، رسم أحزمة البؤس بأسلوب تهكّمي ساخر ونزعة تقشفية وبساطة غرائبية، تحمل المرارة والعذاب. هكذا جسّد شرف الإنسان مصلوباً من الفقر والحرمان، وبجانبه طبق خال إلاّ من نقطة دم، والوجوه كأقنعة مخيفة معلّقة على الأوتاد، وأخذ السكون الوجودي الذي ينسحق مثل صراخ، يتبدّى في لوحاته على نحو كابوسي، وكأنّ الموضوع هو فصل من تمثيلية من النوع العبثي. بينما رسم القطط السود تلتهم العصافير في براءة زائفة، وهي مرتدية أحياناً ربطات عنق، كأنّها في حفل رسمي وفي عينيها شيء من الدهشة. كانت بداية الشعور الفعلي بالقرف، لاسيما مع أحداث النكسة التي عكف بعدها على مراجعة حساباته.
ظهور عنترة البطل الشعبي
حين فاجأ رفيق شرف جمهوره في أوائل السبعينيات، بالبطل الشعبي عنترة وحصانه الذي يجوب صحراء المخيلة الشعبية، بدا كما لو أنّه أمام مفترقين: مفترق مناظره الطبيعية التي تغنّى فيها بالسهول البعلبكية، كحنين إلى طفولة يتلمّس آثارها الباقية في الذاكرة… ومفترق النقيض في لوحاته الجديدة التي تغيب فيها الطبيعة، ليطلع أمامنا هذا الفارس المليء بالعنفوان والكبرياء والقوة والصلابة التي تشبه التمرّد، فيما الحصان يصهل ويسبح ويطير في الفضاء.
انغمس رفيق شرف في إيجاد الروابط بين الذاكرة الشفوية والاستعادة شبه الخرافية للبطل الشعبي، في حلّة زخرفية لونية ومناخات بطولية، مستغرقاً في تجويد الخط العربي وتوريقاته، التي ظهرت في معرض “تقاسيم ومدائح لتغريبة بني هلال” الذي أُقيم في غاليري “كونتاكت” عام 1975، عشية الحرب اللبنانية. فقطف نجاحاً في محيط النخبة البورجوازية البيروتية، مما وضعه في دائرة الضوء وكذلك في دائرة الاتهام، لاقتباسه الموضوع نفسه الذي تداوله الكثير من الرسّامين الفطريين أمثال أبي صبحي التيناوي.
لئن ظهرت المرسومات الخطية العربية في لوحات عنترة وعبلة بطريقة خجولة، مرتدية طابعاً تزييناً زخرفياً بحتاً، ولكنها ما لبثت أن استقلّت باللوحة في مرحلة التعاويذ والحجابات والطلاسم ذات الطابع التجريدي. فطبّق عليها الفنان أسلوب التلقائية العاطفية ، والحركية الارتجالية ثم الأوتوماتيكية المعتمِدة على فعل الكتابة، أي عمل اليد، باحثاً في حروفيته عن مظاهر شعائرية ملغّزة. ومن باب التسلية في المقهى، انغمس شرف في غواية كتابة الحجابات والتعاويذ التي أخذت تفيض من أعماق يجهل ينابيعها ومجاريها ومساربها في كينونته، فعالجها بالغموض السوريالي وبالغيبية نفسها التي تتفق مع طبيعته، متجاوزاً مناخات خوان ميرو وطلسمية التآليف الحروفية في فن بول كلي وتقاسيم كاندنسكي.

من التعاويذ ، فتح رفيق شرف في أواخر السبعينات نافذة على بوابة العشق الصوفي، كي يبلغ سرّ الحقائق الأزلية، مستوحياً فن المنمنمات، لاسيما رسوم الواسطي والأيقونة البيزنطية وشعر الحلاج . في تلك المرحلة كان رفيق قد اقترن من زوجته يولا، منتقلاً من الحياة البوهيمية ونزواتها، إلى الحياة الأسرية واستقرارها، فجاءت هذه الأعمال بمثابة ردّ على موجات الطائفية والمذهبية التي طبعت المجتمعات اللبنانية في عزّ الحرب.
في الأيقونات ، كانت تظهر الأطياف وهي تأوي إلى ركنها السرّي، كي تتوزع وفق مقامات ومراتب: المرتبة العليا للمتصوّف والأدنى منها لحلقات التلامذة المريدين، الذين يجلسون في بستان المعرفة، حيث شجرة الحكمة تتدلّى أوراقها وغصونها في حضرة الذكر الربانية. سعى رفيق للتوفيق بين ثقافتي الإسلام والمسيحية، من خلال روحانية التصوّف التي تتراءى في شكل الهالة الذهبية للقديسين (الأيقونة) وجلسات المريدين (المنمنمة)، في رحلة عرفانية إلى عالم الإشراق النوراني، عالم الزهد والتّرفع.
كان يتحضّر لإقامة معرض في الكويت لم يتمّ، ولكني رأيت ما أدهشني في محترفه قبيل رحيله، إنّها سلسلة من اللوحات الحروفية المرسومة على قماش مستطيل، يحيل مرآها إلى الجداول، حيث تتراءى الحروف مثل كلام منثور في عناق وجريان ليس له بداية أو نهاية.
المصدر: النهار العربي – مهى سلطان