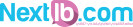إنّ كلّ ما نراه اليوم ليس إلّا تاريخًا مكثفًا يتشكّل أمام أعيننا. فالماضي لم ينتهِ حقًّا، بل يعاد حشده ليصبح مضارعًا نابضًا بالحياة، حاضرًا يمتزج بتفاصيله وكأنه يولد من جديد. وفي الوقت ذاته، يُستدعى المستقبل ليُجعل حاضرًا وكأنه ماضٍ محقق، كأننا نشاهد مشاهد التّاريخ يعاد بثّها، ولكن هذه المرة، في زمن الحضور الكامل.
عجز الفنون السّبعة
هذا التّكثيف الزّمني يُسطَّر في صفحات ناصعة تعجز فيها الفنون عن التّعبير؛ الفنون السّبعة عجزت، فقد أخرست الأحداث الشّعر لأن الصّورة أبهى وأعمق تعبيرًا. فعندما يقف الإنسان أمام مشهد يتجاوز كل خيال، يصبح الخيال نفسه باهتًا.
لم تعد الكلمات قادرة على التقاط ما يكثّفه الواقع من مآسٍ وحسرات ولهفات وخيبات وارتفاعات وانخفاضات وانحسارات وانتصارات… وأكمل المتوالية إلى ما شئت مع حفظ المفارقة والتّكثيف في آن.
لقد انطفأت سينما التّخذيل، التّي طالما حملتنا إلى عوالم لم نرها، أو رأينا ذيولها من قهر وظلم واحتلال واستعمار …انطفأت هذه أمام وهج الواقع الحيّ. فلا يمكن لأيّ كاميرا أو نصّ أن يصوّر الألم الذي يُبث في كل لحظة، ولا يمكن لأي سيناريو أن يختزل الوضوح الصّارخ الذي يعيشه القوم في ساعات يومهم وتفاصيله. حتى مشاهد تحرير القدس في دراما حاتم علي، رغم عظمتها، أصبحت تبدو كخزعة باهتة أمام المشهد الحقيقي الّذي ينبض كالبثّ الحيّ في كلّ حيّ، وامزج ذلك مع متوالية عماد الدّين فنور الدّين فصلاح الدّين،… سينما أو واقع؟ وما زلنا مع حاتم علي (فقيد المشهد).
نعيش في زمن لا يسمح بالتّرميز أو التجميل. كل شيء أمامنا مكتمل وضوحه، يفرض نفسه دون حاجة إلى مجاز أو استعارة. إن التاريخ الذي نراه الآن هو الحقيقة نفسها: صادقة، صارخة، وغير قابلة للمواربة. وفي هذا المشهد، يتداخل الماضي مع الحاضر والمستقبل لتصبح جميعًا وحدة واحدة، زمنًا مستمرًّا يعيد إنتاج نفسه بلا توقف.
إنه عصر أخرس الفنون التقليدية وجعل الواقع مسرحًا لا يمكن تجاوزه. لوحة الحياة اليوم ليست فقط “مستوحاة” من التاريخ؛ بل هي التاريخ نفسه يعاد خلقه بشكل مباشر، دون وسيط أو مسافة.
التاريخ المضارع وانفجار المعجم
معلوم أن حركة المعجم أكثر بطئًا من حركة التّاريخ، فتحتاج الكلمة المفردة أزمنة وأجيالًا ليتغيّر معناها، ولتلبس دلالات جديدة، لكنّ هذا الأمر بدأ يتغيّر أيضًا. أمام أعيننا، وببثّ حيّ مباشر، نشهد كيف يتغيّر المعجم بسرعة الأحداث نفسها. والكلمات التي كانت بالأمس تحمل معاني السّخرية والسّبة، أصبحت اليوم رموزًا للمديح والمأثرة. والعكس صح أيضًا، فقد يحدث انقلاب في دلالات الكلمات بين ليلة وضحاها، بما يشبه الانفجار، وبخاصّة وأكثر تخصيصًا في الكلمات المزوّرة، أو ضعيفة الرّصيد، أو المشحونة بدلالات غاصبة، وبدت سريعة التّصريف والانعتاق من ذلك الشحن البغيض، فاللّغة اقتصاديّة، نخيّة أيضًا.
كان التّاريخ يُكتب بالشّعر (ديوان العرب) ثمّ بالوثيقة، لكنّه اليوم لا يُكتب فحسب، بل يُشاهد. بات كلّ شيء حيًّا يُطوى فيه الزّمن، ليجمع ظرف الماضي وظرف الآتي في لحظة واحدة. في هذا الزّمن المضغوط المكثّف، يصبح الجميع سواء: الصّانع، والكاتب، والقارئ، وحتى المتنحي والمنسحب. جميعهم يشتركون في هذا الظرف الواحد الّذي يتحوّل إلى رسالة حيّة، تنام في ظرفها لتكون للقراءة من بعد أو للنّسيان.
إن هذا الواقع الجديد يجعلنا ندرك أن الكتابة لم تعد الوسيلة الوحيدة لتوثيق الزّمن، بل أصبح الوجود في حدّ ذاته جزءًا من النّص التّاريخي. في هذه اللّحظة الفريدة، المعجم والتّاريخ والحاضر يتشابكون ليُنتجوا سردًا جديدًا يعيد تعريف دور الفرد والجماعة في صناعة الزّمن.
هذا هو التّاريخ المضارع الّذي يكتب فصوله أمامنا بدماء، ودموع، وابتسامات متشبثة بالحياة رغم كل الآلام. إنّه المشهد الحيّ الّذي يجعلنا جميعًا شهودًا على زمن لن يكون يومًا طيّ النّسيان. وإذ جعلنا شهودًا فقد حمّلنا مسؤليّة فرديّة، وأخرى جماعيّة.
سيرتك في السّرديّة
بناء على ما سبق، إنّ الفرد مسؤول عن كتابة سيرته كما هو مسؤول عن كتابة سيرة أمّته، لا سيما في وقت عطائه وإنتاجه. ففي لحظة يقف فيها الإنسان في منتصف العمر، كمن وُلد في ستينيَّات القرن الماضي- مثلًا- وقد بلغ اليوم خمسين عامًا ونيّفًا، عليه أن يتوقّف ليسأل نفسه: ماذا أنجزتُ في زهرة العمر؟ وأين كنت مع من أنجزوا؟
السّؤال ليس سؤالًا فرديًا فقط، بل هو سؤال جيل أو أجيال متقاربة ومتزامنة؛ سؤال سيطرحه الأبناء والأحفاد، وأبناء الأتراب وأحفادهم، وكذا صفحات التّاريخ المدوّن والمصّور، والمنطوق. حينما يُسأل الفرد أو الجيل مِن هؤلاء: “ماذا فعلت في وقتك؟”، عليه أن يكون مستعدًّا للإجابة، مستحضرًا إنجازه القصديّ – إن وجد- وأين كان موقعه من إنجازات الآخرين.
هذا السّؤال الحاسم يجعلنا نفكر: هل كان هذا الفرد صانعًا للتّاريخ أو كاتبًا أو محرّرًا أو قارئًا واعيًا؟ أم كان مشوِّشًا على كتابة ناصعة؟ هل أسهم بجهوده في رسم ملامح التّاريخ المضارع في زهرته، أم كان عائقًا أمام التّقدم في الحدث، يضيف ظلالًا، – وعتمة إن استطاع- على صفحات كان يمكن أن تكون أكثر إشراقًا؟ هل كان مع السبّاقين، أو السّابقين، أو المماشين، أو المنعطفين (المكوّعين)، أو المحايدين، أم أنه وجد نفسه في منعطف ضيّع فيه الاتجاه؟ أم كان متخاذلًا، بل ومخذِّلًا؟ يجب أن يكون حاضرًا للإجابة: “في أيّ مربّع من الصّورة كنت؟” هذا السّؤال لكلّ فرد مرّة، وللمثقف ألف مرّة.
فالتّاريخ المضارع لا يكتب نفسه فقط من خلال الأحداث الكبرى، بل من خلال الأفراد الّذين يختارون بين أن يكونوا مشاركين فاعلين أو متفرجين سلبيين. الإنسان ليس مسؤولًا عن أفعاله فحسب، بل عن الامتناع عن الفعل حين يكون الفعل مطلوبًا. مسؤول عن الفكر الّذي ينتجه، عن المواقف الّتي يتخذها إقدامًا أو إحجامًا، وعن الإرث الّذي يتركه.
وكما أن الأمم تُسأل عن حاضرها، كذلك يُسأل كل فرد عن زهرة عمره. هل كان جزءًا من سياق الإنجاز، أم ترك نفسه لتيار الحياة دون أن يترك بصمته؟ هل كان مبدعًا يسهم في صياغة تاريخٍ جديد، أم كان مجرد مستهلك لأحلام الآخرين؟
في التاريخ المضارع، لا مكان للتّردّد أو الانسحاب. إنه زمن يتطلّب الوضوح والعمل، ومن لا يكتب سيرته بحروف مشرقة اليوم، سيجد نفسه غدًا على هامش كتاب التّاريخ، حيث لا تُقرأ الصّفحات الباهتة.
د. حسين عبد الحليم
أستاذ جامعي – باحث في اللّسانيّات