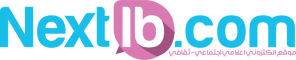كان يوم السادس من حزيران من عام 1960 أي في مثل هذا اليوم منذ 60 عاماً بالتمام والكمال ، مشهوداً في قريتنا المنارة البقاعية ، إذ تدفقت مياه نبع شمسين عذبة باردة في ساحتها بعد أن أوصلت مصلحة مياه شمسين أنابيب المياه اليها لتبرز الى المشهد القديم “حنفية” ضخمة كانت تصب داخل جرن إسمنتي ألصق في حائط سور حديقة منزل ” البيك” ، و”البيك” لمن لا يعرفه من أبناء الجيل الحالي ، أو من غير أهل الضيعة ، هو الإقطاعي الذي كان يشارك أهل البلدة رزقهم وعرقهم وقوت عيالهم ، جرجي بك رزق الله ، الذي سيرد ذكره في متن القصة التي سأرويها لكم ، لتنتظر القرية تطوراً آخر يحمل الماء في القساطل الى المنازل ، فتصل ربات البيوت الى قمة السعادة بعد عقود طويلة من التعب ، ولتبقى “عين القنا” مع رفيقاتها “عين أبو حلفين” و”عين سفراح” بعد اندثار “عين الصوان” وإبتلاع أرضها وبيعها ، شاهدات على معاناة أهل البلدة التي استمرت لعقود طويلة من العذاب إمتدت من قبل الحرب العالمية الأولى والثانية حتى مطلع الستينيات ، مع مشقة الذهاب الى عيون الماء الواقعة غربي البلدة للتزود بالماء على ظهر الدواب ، وانتظار “الدور”عند مزراب العين لملء الجرار الفخارية ، والعودة بالماء الى البيوت المعدودة حينها والمتجمعة بألفة عند سفح الجبل .
ولكن هذا لم يكن يمنع صبايا البلدة أيضاً من حمل الجرار الفخارية على رؤوسهن برشاقة ، رغم التعب والجهد الذي كُن يعانينَ منه ، فموقع العين القريبة ، “عين القنا” في أسفل البلدة والطريق منها يلتف صعوداً الى البيوت في أعلاها ، ويتطلب الأمر مشقة وقوة لتصل جرار الماء الى البيت وتأخذ مكانها في ” الجلاسة” ، وهذه الأخيرة هي القاعدة الخشبية المحفورة من الوسط لحمل الجرة بشكل مستقيم كي لا تقع ، وغالباً ما كانت تأخذ مكانها خلف باب الدار ، وكان حمل الجرار على رأس الصبايا يحصل في معظم القرى والأرياف اللبنانية حينها ، وبالطبع لم يكن يَحسبن بأنهن سيدخلن التراث والفولكلور ومسرحيات الرحابنة بجرارهن الفخارية التي صارت بعدها جزءاً من التراث والدبكات .
عند مزراب العين
مع مطلع كل صباح وعند كل غروب وقبل عام 1960، كان أهل البلدة يذهبون على ظهر الدواب الى العين للتزود بمياه الشرب والخدمة المنزلية فيركزون “القنتلة” على ظهر الدابة ، و”القنتلة” إصطلاحاً هي كناية عن سلة مزدوجة مفتوحة حيكت من أغصان الأشجار الدقيقة قبل جفافها ، ثم تم تجفيفها لتصبح صلبة وقوية وتستوعب الجرة ، وتحتضنها وتحميها في نفس الوقت من الكسر ، ولكن هذه المعاناة اليومية كانت تجبرهم على الإنتظار “بالدور” عند مزراب العين .
وكان يخرق هذا “البروتوكول اليومي” المقدس صوت أجش يحمل صيغة التهديد : ” أبعدوا جراركم إجا (وصل) حمْل بيت البيك” وهذا الصوت غالباً ما كان لخادم بيت البيك جرجي رزق الله ، الذي كانت له الأفضلية في التزود بالماء دون الإنتظار بالدور ، يوازيه في الأفضلية “حمْل” مياه الدرك “الجندرمة” الذين كانوا يقطنون في المخفر القريب خلف محطة الوقود التاريخية للمرحوم أبو يحيى الخطيب ، هذا المخفر الذي بقيت أطلاله صامدة حتى أعوام السبعينيات قبل أن يهدم .
تحت حكم الإقطاع
وقصة “البيك” الإقطاعي جرجي رزق الله أنه كان من الأعيان في أيام الدولة العثمانية وخلال الحربين العالميتين ، واستمر نفوذه إبان حكم الأمير فيصل في سوريا في العشرينيات من القرن الماضي على دمشق ، وقد قام بمسح أراضي القرية أو معظمها بإسمه متذرعاً بأنه سيقوم بدفع الضرائب للدولة العثمانية عن أهل البلدة ، على أن يشتغلوا عنده بالأرض وكأنها ملكهم ، ويقوم هو بإستلام المحصول منهم على البيدر ، وبقسمة المحصول ليعطيهم حصة صارت تصغر رويداً رويداً حتى باتت لا تكاد تكفيهم مؤونة الشتاء مع البذار للعام المقبل ، ليجمع المحصول والغلة في ” الحاصل” وهو مخزن حبوب البلدة و”أهراؤها “، وكان يقع أسفل ساحة الضيعة، ليقوم ببيعه الى خارج البلدة .
واستمر الحال كذلك لعقود عديدة قبل أن يقوم أهل البلدة تدريجياً بشراء الأرض مرة جديدة من أبناء “البيك” رزق الله بمعظمها مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 75. ليتخلى البيك كذلك عن منزله الفخم (حينها ) ببوابته العالية وجدرانه الحجرية المقصوبة والواقع في وسط البلدة في سنوات لاحقة ، وتتملكه البلدية لتوسعة ساحة البلدة منهية بذلك أحد رموز الإستغلال الذي استمر في القرية لعقود طويلة من الزمن وحتى وقت غير بعيد . ولنعلم مؤخراً بأن بعض العقارات في البلدة لا تزال مملوكة لأحد أبناء “البيك”.
ذكريات سعيدة …وأخرى
دعنا هنا عزيزنا القارئ نسرد الذكريات الطيبة عن وصول الماء الى ساحة الضيعة في مثل هذا اليوم السعيد ، وحالياً صار للقرية بئر أرتوازي مستقل بعد أن شحت مياه نبع شمسين ، ومولد كهربائي نشيط يخدم البئر الأرتوازي ، على أن نتطرق الى منغصات الذكريات التي صودف أن جميعها كانت تأتينا في مطلع حزيران بدءأً من “نكسة” حزيران (وهي هزيمة حقيقية) في عام 67 وصولاً الى العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان الذي حصل في نفس التوقيت تماماً ولكن في عام 82 ، وسنأتي على ذكرها في مقاربات لاحقة بإذن الله .