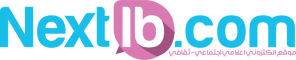أبو ظبي _خاص
شكّل الزمن الرقمي وما رافقه من انتشار لموجة وسائل التواصل الاجتماعي في العقد الأخير مناسبة لعدول المجتمع اللبناني عن نوبات “الدراما” التي كانت تصيبه كلما قرر أحد مغادرة لبنان الى الخارج للعمل في فرصة أفضل أو للاغتراب.
فما جرى أن استُبدلت “الشهقة” التي كانت تسابق عبارة “مسافر؟” بصمت لعشر ثوان تليها “صفنة” من ثانيتين فعبارة “يلاّ الله يوفقك” انطلاقا من أن هذه الوسائل الرقمية باتت توفر فرصة الاتصال بالصوت والصورة والتواصل مع الأهل والأصدقاء في أية لحظة على عكس حالة الاغتراب في التسعينيات والثمانيات حين كنّا نكاد ننسى وجه المسافر فنعوّض غيابه باتصالات هاتفية دولية مكلفة وغير متوافرة دوما إلى جانب الرسائل المكتوبة والتسجيلات الصوتية له عبر الكاسيت.
عندما نضع العملية في هذا الإطار الموضوعي لا أكثر، تصبح الغربة بالنسبة لنا مسألة وقت يمكن تمريرها بتعبئة الساعات بالإنتاج والعمل غير أن للحظة الحقيقة دوما سحرا خاصًا يقتل الاختراعات والابتكارات في لحظة واحدة فتعود أفكارنا كلاسيكية وتقليدية لا تقوى على تقبل صورة البُعد والفراق، ومن حيث لا ندري تبدأ مشاعرنا بنبش مواقف نخال زمنها قد ولّى وإذ بها تعود لتكون بحق سجلاً يوثق يوميات الغربة.
صحيح أننا بمجرد لمس شاشات هواتفنا الذكية قادرون على الدخول “مرئيا” الى بيوتنا وتبادل الأحاديث وكذلك التحديق والنظر في وجوه وعيون من نحب، إلا أن عوامل مقلقة تبقى ترافق هذه العملية كل يوم في الغربة، أسخفها امكانية انقطاع خدمة الانترنت ومعها بطبيعة الحال المحادثة المفتوحة.
هذه اللحظة مثلا كفيلة وحدها بتهشيم ابتسامتك وقلب مزاجك وإعادة رسم الغربة بالصورة المحزنة التي نهرب منها الى الأمام من خلال طلب نجدة كل باقات التواصل الاجتماعي وقيسوا على ذلك فيما بعد أي خبر مقلق من لبنان أو حادث لا قدر الله أو أي تفصيل غير ايجابي.
تجربتي لم تقفل شهرها الأول بعد، ومجيئها خلال فصل الشتاء شكّل قسوة أخرى بحد ذاتها لأنني من خلال محادثاتي المرئية اليومية مع زوجتي وأهلي واخوتي وأصدقائي أرى “عدّة الفصل” من البطانيات الى كانون أمي وأرغيلتي أبي وخالتي وشالات زوجتي ومعاطف أصدقائي السميكة لكنني لا أقوى على لمسها أو الشعور بها كما ينبغي لأستطيع القول أنني شبعت من شتاء بيروت هذا العام.
الزمن الرقمي في الغربة يعزّي بصرنا الى حد كبير وكذلك بصيرتنا عندما تبث فينا صور الحنين مشاعر الارادة والثبات لكنها حتما تبقى غير قادرة على مسح دمعات “قلوبنا الشرشوحة” واستخدم صفة “الشرشحة” هنا ليس لأغزل نهاية جذّابة بل لأعاتب وبنبرة مرتفعة لكن حليمة طيبتي وطيبة كل متعلق ببيروته الى هذا الحدّ.
قد يكون من الصعب استحداث تقنيات تمكننا من لمس ومصافحة ومعانقة وتقبيل من نحب عن بُعد، لكن الأكيد إننا بحاجة لتقنية عاجلة تمدّنا بشيء من عطر بيروت الشتوي وعبق بيوتنا المزهوّ بالدفء هذه الايام في بيروت رغم أصناف العواصف واسمائها المفذلكة.
كتابتي لهذه الخاطرة عوض الاطلالة بهذا المضمون مُستخدمًا تقنية الـ “اللايف” عبر فايسبوك والفوز برقم مهول من الاعجابات والمتابعين مثلا، دليل ساطع على أننا في الغربة نعود إلى صفائنا ونقاء عفويتنا.
أما للمستفسرين “بسماجة” نجيب: نعم، نستمعُ الى صوت فيروز كلَّ صباح ويخفق قلبنا متى تسلل صوت ماجدة الرومي الى مسامعنا في رائعة “يا بيروت” ونتهّد تنهيدة وافية تُنسينا النَفس المقبل عندما تمر “إخباريا” أمامنا صور روشتنا ومنارتنا.
رغم الزمن الرقمي، هذا هو البيروتي في غربته، كتلة ليّنة من حنين!
عمر الفاروق النخال *
كاتب وصحافي لبناني