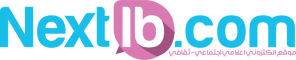ماذا لو لم تأتِ المساعدات والقروض الدولية لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي؟ وماذا لو أتت شحيحة جداً لتقتصر على الغوث الإنساني فقط؟
ماذا لو كانت الجهات المانحة وعواصم القرار المؤثرة في مؤسسات التمويل الدولية جادة في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية لا يستطيع لبنان تحملها حالياً مثل عزل حزب الله تمهيداً لضربه؟ وهل يصح إلى ما لا نهاية ان يعلق اللبنانيون مصيرهم على مفاوضات أميركية ـ إيرانية قد تمتد لسنوات، وقد لا تفضي الى النتيجة المرجوة منها؟
هل نبقى أسرى ما ستؤول اليها الملفات السورية والعراقية واليمنية في وقت تتسارع فيه خطى التطبيع الخليجي الإسرائيلي وتتعاظم في موازاته أدوات النفوذ التركي وتتجذر نزعات العناد الإيراني؟ أم أن هناك سبيلاً آخر يمكن سلوكه مرحلياً أو بشكل مستدام؟
هل الإقدام على أي اصلاح مرهون فقط بوعد صندوق النقد الدولي بقروض ميسرة؟ وهل التدقيق في الحسابات سواء أكان جنائياً أم غير جنائي لمعرفة حجم الفجوة المالية لا نقوم به إلا كرمى عيون جهات دولية تطالب بالتدقيق؟
هل نمعن في أسعار صرف يتراوح الفرق فيها بين 150 و450 في المائة في حالة ضياع لا مثيل لها في العالم؟ وهل نبقى متمسكين بنموذج مصرفي صار عبارة عن جثث متحركة (زومبي)؟ وهل نتمادى الى ما شاء الله في البكاء على الإناء الإقتصادي المكسور واللبن المالي المسكوب؟
هذه الأسئلة، وغيرها من القبيل عينه، ليست غائبة عن بال قلة قليلة من أهل الحل والربط، لكن سؤال البدائل هو الأصعب.
المأزق الوجودي
أسئلة تطرح نفسها بعدما اتضح جلياً في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، الأسبوع الماضي، أن ما اصطلح على تسميته بـ “المجتمع الدولي” لن يمنح السلطة القائمة ما تريده من أموال لترميم نفسها بعدما تصدعت أركانها وبات الفساد سمة توصم بها على رؤوس الأشهاد العالمية ، كما أن الدول المانحة الأساسية باتت أكثر وضوحاً في ما خص سلاح حزب الله وحضوره في التمثيل السياسي أو الحكومي، وبالتالي يجد لبنان نفسه من جديد في مأزق أخطر من كل المآزق السابقة وفقاً للمعادلات الإقليمية والدولية المحتدمة حالياً على جبهات اصطفافات حادة بين مشروعات متناقضة حد الإقتتال سبق للبنان أن دفع أثماناً باهظة لها، لكن الثمن هذه المرة أصبح “وجودياً”، كما تقول فرنسا التي تحذر “من زوال لبنان “، كما ورد ويرد على لسان كبار مسؤوليها.
عاش لبنان طويلاً في ظل وهم القروض والمساعدات العربية والدولية، والتي اذا جمعناها في مدى 30 سنة لن تتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دولار، علما أن بعضها سدد وبعضها الآخر قابله منافع ومصالح لهذا الطرف أو ذاك، ولم تتأمن استمرارية الدولة وإنفاقها الهستيري إلا بفضل الدين الداخلي بالليرة اللبنانية والغرف زوراً وبهتاناً من ودائع اللبنانيين الدولارية التي تبخرت عن بكرة أبيها تقريباً.
عاش اللبنانيون وهم المساعدات والقروض الدولية التي تكاد لا تساوي 15 الى 20 في المائة من إجمالي الدين العام، علماً بأن جزءاً كبيراً من سندات “اليوروبوندز” اكتتبت به المصارف المحلية ومصرف لبنان ومستثمرون محليون وجدوا فيها ضالتهم لجني أرباح فوائد سهلة، فضلاً عن الهندسات المالية التي معظم أبطالها من صنع محلي ، إذاً، لماذا الإمعان في الإعتقاد أن لا إنقاذ إلا بأموال الخارج كما لو أن نموذج التسول ممسك بجلابيب اقتصادنا حياً أو ميتاً الى ما شاء الله وقدّر؟
أما وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه في ربع الساعة الأخير، قبل الإنهيار الكبير، فالنقاش يتحول تدريجياً الى ما تبقى لدينا من أموال وأصول يمكن التصرف بها. وهنا نتحدث عن 17 مليار دولار يقول مصرف لبنان أنها بحوزته تحت عنوان “الإحتياطي الإلزامي”، تضاف إليها قيمة الذهب المقدرة بنحو 16 مليار دولار، وقيمة صندوق سيادي يضم عقارات وشركات ومؤسسات ومرافق عامة اقترحته المصارف، ووافق مصرف لبنان عليه ضمنياً، كما وافقت عليه شرائح واسعة من الطبقة السياسية، وقيمته لا تقل عن نحو 40 مليار دولار (يمكن الخوض لاحقاً في مسألة كيفية وأهداف استخدام هذا الصندوق وإيراداته(. نظرياً، هل يمكن مع 73 مليار دولار (كاش وأصول) تشكيل خميرة جديدة لعجين اقتصاد يختمر ليخبز على نار التحول الجذري من التسول إلى الإنتاج؟
بداية ثمة إشارة إلى أن التقشف الشديد في الإنفاق شرط أساسي لأننا نلعب آخر أوراقنا على طاولة الحياة الحرة بكرامة أو الموت الشنيع بسقامة، الشرط الثاني هو الإنفاق بنزاهة ما بعدها نزاهة، وبفعالية وجدوى إقتصادية في سياق مشروع إنتاجي جديد لا يمت إلى تاريخنا القائم على المضاربة بصلة بعدما فقدت معظم الأطراف ترف التصرف على قاعدة إضرب واهرب ، فالعقارات لم تعد للمضاربة، والدولارات لم تعد للربى الفاحش، والذهب ليس زينة نتمظهر بها في معاصمنا بينما أرجلنا غارقة في الوحل.
5 عواصم بديلة لبيروت
رب قائل أن المتبقي من دولارات في مصرف لبنان هو للمودعين والتصرف به خط أحمر، وأن أصول الصندوق السيادي للأجيال القادمة وليس الحالية، وأن التصرف بالذهب أشبه ببيع مجوهرات العائلة لشراء الخبز والطعام، في ما يشبه الإفلاس المؤجل إعلانه إلى أجل قريب.
بيد أن الردود بسيطة وتبدأ بالسؤال عن البدائل غير المتوفرة بإنتظار القروض والمساعدات التي قد لا تأتي، واذا أتت كما يشتهي المراهنون سنفاجأ جميعاً بأنها غير كافية للتعويل عليها لإعادة إحياء النموذج القديم الذي قام على وهم أهمية لبنان في المنطقة والعالم، وتبين أن ذلك الوهم ليس إلا أسطورة في الإقتصاد بعدما بات لبيروت 5 عواصم بديلة على الأقل في المنطقة، تضاف اليها تل ابيب مع موجة التطبيع الخليجي مع العدو الإسرائيلي.
لا دولارات حقيقية في مدى 5 سنوات
وبين الردود الممكنة على المشككين أن الذهب لحماية الليرة، فاذا بالليرة منهارة، وان العقارات ملك الاجيال القادمة متجاهلين أن تلك الأجيال تريد منا اقتصاداً منتجاً يولد فرص عمل واكتفاء ذاتياً ، ولا تريد عقارات تستخدم في المضاربات وفي الرهونات الإئتمانية لتسليفات تذهب في الإستهلاك ولا تريد أن نرهن مستقبلها المرهون لقروض جديدة ، أما الرد على أن الدولارات الباقية للمودعين فهو أبسط من الردود السابقة ، فلا دولارات إلا بالليرة وبسعر صرف 3900 ليرة للدولار اليوم وربما أكثر بكثير غداً ، وعلى المودعين الإقلاع عن حلم قبض دولار حقيقي في أيديهم في مدى 5 سنوات على أقل تقدير وأكثره تفاؤلاً ، وأفصح دليل على ذلك ما كشفه بصراحة فجة وصادمة رياض سلامة عندما أكد أن الودائع ليست لديه بل في المصارف، ويقصد بذلك ودائع الليرة المتاحة مع بعض القيود، وودائع “اللولار” كما يسميها دان قزي، الخبير المالي المهضوم والذائع الصيت في محطات التلفزة، أي لا دولارات حقيقية باقية مطلقاً بل ليرة بالسعر المتهاود والمقصوص الشعر (هيركات)، والمحلوق حتى البصيلات.
دعم القطاعات الإنتاجية
أما كيف السبيل إلى ذلك التخمير المؤدي الى عجين قابل للخبز، فتلك مسألة تحتاج الى عقول اقتصادية لا تنقص في لبنان، تضع نصب أعينها القطاعات الإنتاجية بتوفير التمويل المدعوم لها والعقارات بأسعار تأجير تشجيعية وأسعار طاقة مقبولة ودعومات أخرى تجعل الكلفة تنافسية لسلع وخدمات قابلة للتصدير وجلب الدولارات الطازجة ، وهذا يحتاج تحولاً نوعياً في الوعي، ووقتاً يمتد لسنوات لأن عوائد الإنتاج ليست فوائد مصرفية تقبض سريعاً بلا أي جهد، ولا تشبه أرباح العقار المحمومة في بلد الأرز “الأسطوري” المتحول الى غابات اسمنت مسلح قبيح، والفندقة السهلة الريع بالشطارة التسويقية غير السوية والخدمات الوسيطة بالفهلوة الغشاشة والأسعار الفالتة، والتجارة المحتكرة من 8 شركات فقط تسيطر على 70 في المائة من الأسواق بإعتراف وزارة الاقتصاد نفسها.
لعل البداية في علاجات للداهم من الإستحقاقات، أي مأزق رفع الدعم وما يطرح على اللبنانيين من خيارات قاسية ، نعم يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة ، لنأخذ نموذج المحروقات، ينتظر لبنان قراراً يفترض أن تتخذه الحكومة العراقية، بناء على تفاهم بين رئيسها مصطفى الكاظمي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يقضي ببيع لبنان النفط الخام بسعر الإستهلاك في السوق العراقية، على أن يتولى لبنان التكرير في إحدى المصافي الإقليمية (الأرجح في مصر) ، هذا الخط العراقي ـ اللبناني لا أحد يضع “الفيتو” عليه ، حتى أن الدفع يتم سنوياً ويمكن أن تحسم منه بعض عائدات التصدير اللبناني إلى العراق من صناعات غذائية وخضار وفواكه وغيرها.. يسري ذلك على القمح الذي يمكن إستيراده من سوريا بأسعار تفضيلية أو مقابل توريد بعض حاجات الشعب السوري من الأسواق اللبنانية. أما فاتورة الدواء، فقد آن الأوان لإنهاء إحتكار “البراندات” العالمية من قبل أربع أو خمس أو ست شركات تحقق أرباحاً خيالية من أصل فاتورة دواء لا تقل عن مليار و200 مليون دولار سنويا ، ليذهب لبنان إلى دواء “الجنريك” ويضع نفسه على خط التحول إلى سوق رئيسي للدواء المنتج محلياً بمواصفات عالمية، وثمة بنية تحتية وخبرات وكفاءات تساعد على أخذ هكذا قرار ، أيضاً يسري ذلك على سلة من المواد الغذائية المدعومة والتي يمكن حصرها (أي عشرات المواد بدل المئات).
لا ثقة بالقطاع المصرفي
سنجد دائماً من يتهكم على الطرح الإنتاجي، لأن النموذج الذي يحتضر، وظنه الجميع مستداماً، كان يقوم على تحويل دولارات المغتربين التي باتت الآن خارج المعادلة بعدما بدأت تشح من جهة وفقدت ثقتها بالقطاع المصرفي من جهة ثانية، وعلى دولارات السياحة التي تموت موتاً سريرياً لسنوات طويلة قادمة، والإستثمار الأجنبي الذي وجد ضالته في أمكنة أخرى أقل فساداً وأضمن مردوداً، وعلى قروض ومساعدات دولية باتت مشروطة على نحو قد يفجر البلد بدءاً من التدقيق الجنائي وصولاً الى سلاح حزب الله وما بينهما من شروط تلتف حبالها على أعناق الجميع رويداً رويداً حتى الرمق الأخير من هذا النظام البالي.
منير يونس
صحافي وكاتب لبناني
* الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي كاتبها