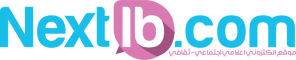“لم تنس بيروت كبار مبدعيها”، تلك هي رسالة المعرض الاستذكاري احتفالاً بمئوية الفنانَين جان خليفة (1923- 1978) وهلن الخال (1923- 2009)، والمُقام في قاعة الشيخ زايد في مبنى الصفدي في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU
ولا شك بأن المنظمين أرادوا من خلال هذا المعرض إعادة اكتشاف الطروحات الجمالية والفكرية لدعامتين من دعائم الحداثة التشكيلية في لبنان. فكلاهما تمرد على السائد من أجل تغيير مفاهيم تجريدية شهدت زخمها العاصمة بيروت في عصرها الذهبي، منذ ستينات القرن العشرين.
يقدم المعرض الذي ينظمه القيّم الفني في الجامعة د. طوني كرم بالتعاون مع الفنان جوزف فالوغي ، وهو خبير من الطراز الرفيع، مختارات من الأعمال التي تعود إلى جيم جان خليفة (ابن الفنان) ومقتنيات الناقد الراحل سيزار نمور مؤسس متحف “مقام” للفن الحديث والمعاصر، والفنانَين سليمى وإبراهيم زود، وهي تلقي الضوء على محطات بارزة من المسار الفني لكل من الخال وخليفة، منذ انطلاقتهما من الدراسة في الأكاديمية اللبنانية ALBA إلى مراحل النضج والتجريب والتطلعات التي عايشاها في غمرة القلق والصراع والتجديد والابتكار في خوض مغامرة التجريد.
لئن أخذ خليفة الفن نحو التعبير باللون والحركة الدينامية للأشكال وتفجرات الخطوط متأثراً بالتجريد الغنائي في التجارب الفرنسية، فإن ريادة هلن الخال تتبدى في المقلب الآخر أنها أدخلت مفاهيم التجريد اللوني المتصل باللون وتأملاته الفلسفية في الفن الأميركي إلى المشهد التجريدي في لبنان.
وأهمية المعرض أنه يقطف تنوعات من التجارب تعكس هذا التقاطع ما بين مدرستي باريس ونيويورك، كما تؤكد وجود القواسم المشتركة بين الفنانَين تكمن في عدم غياب الواقع كلياً عن تجاربهما، لا سيما في حضور الأنثى العارية والعلاقة بتأملات الطبيعة من زوايا قريبة من القلب والنفس.

هلن الخال والرّيادة الفنيّة
من الستينيات حتى التسعينيات، تتراوح معظم لوحات هلن الخال بين مناظر طبيعية وآفاق تجريدية. أحد أكثر الأعمال تميزاً هي لوحة مريم (أول موديل عارٍ في الأكاديمية اللبنانية)، التي تتمثل بأسلوبها الشفيف في التلوين وتفسير الأبعاد وتناسق علاقات السطوح الهندسية المتقاطعة على طريقة التكعيبية.
هذا الأسلوب الذي انسحب على رؤيتها التبسيطية في رسم مناظر من خلجان بحرية وهضاب وحدائق وسهول تعكس سحر الطبيعة اللبنانية، التي عشقتها وظلت تحنّ إليها طوال سنوات غربتها الأميركية.
فالصراع الذي عرفته حقبة الستينات بين الواقع والتجريد والشكل واللا شكل، حسمته هلن الخال لمصلحة اللون، كمبدأ جمالي سعت إليه منذ بداياتها الفنية كي يصل اللون إلى اللمس البصري المتصل بالحواس، والارتقاء به إلى أقصى الصفاء، أي المطلق.
لعلّ ميزة أعمال هلن الخال هي تلك الموسيقى الضوئية التي تنبعث من اللون، إذ ليس ثمة خط أو وجود لحافات صلبة تنتهي عندها الأشياء كي تبدأ أشياء أخرى، بل التماهي والشفافية هي سمات ريشتها التي لم تتخل يوماً عن تقنية الألوان الزيتية.
لقد رسمت الآفاق المتدرجة بتناغماتها الداخلية، لكنها لجأت إلى كسر الصمت اللوني وبرودته، حين وضعت حقول اللون في تركيب هندسي، إما مستطيلين (أو ثلاثة)، وإما مربعات داخل مربعات في تداخل يشمل فضاء اللوحة بأكمله، انسجاماً مع تأثيرات “ألبرز” و”روثكو” و”نيومان” وسواهم من الفنانين الذين فجروا إمكانيات التعبير اللوني في التجريد الأميركي، بغية مضاعفة تأثيراته وتموجاته البصرية.
ولكن، رغم نشأتها الأميركية وتأثرها بالتجريديين الأميركيين، لم تصل هلن إلى حدود الثورة نهائياً ضد الموضوع، إذ ظل الحنين إلى الواقع يناديها كحاجة إلى البوح لاكتشاف حقائق جديدة مع الطبيعة والناس وأرض الجذور.
هلن الخال تلك الشخصية اللافتة، بصدقها وبساطتها وترفّعها، صاحبة الفضل على حركة الفن الحديث وحركة النقد في لبنان، مولودة في “ألن تاون” في بنسلفانيا من أبوين مهاجرين. انتسبت إلى الأكاديمية اللبنانية عام 1946 حيث تابعت دراستها حتى عام 1948.
هي رائدة في أفكارها وتوجهاتها، أسست أول غاليري احترافية في بيروت، أطلقت عليها اسم “غاليري وان” شكّلت منصة لفناني الحداثة اللبنانيين والعرب. كانت حياتها كفاحاً وصراعاً بين أقطاب منافسين، لا سيما تجربة زواجها ومن ثم طلاقها من الشاعر يوسف الخال التي أورثتها الكثير من المعاناة.
وجدت في الكتابة الوجه الآخر للإبداع، بدأت بالكتابة النقدية منذ عام 1967 في الديلي ستار والموندي مورننغ، وتقلبت في مناصب عديدة تقلدتها في مكتب الإعلام الأردني أثناء توليها رئاسة تحرير مجلة اقتصادية وثقافية باللغة الإنكليزية، لتنتقل إلى واشنطن بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1977-1991). في عام 1987 أصدرت كتاباً بالإنكليزية وثّقت فيه المسار الفنيّ الشاق للفنانات النساء في لبنان في اختراق القيود الاجتماعية.
كان سلامها الداخلي ينعكس صفاءً رحيباً وعميقاً في علاقتها بفنها، فكل لون من مزيج قواريرها يطل جديداً على العين. فالألوان تهيمن في تأثيراتها البصرية، إما باردة ومطمئنة أو انفجارية كطراز ألوان البراكين وغروب الشمس، تأتي في قائمتها سلالات الأزرق والأرجواني والوردي والقرمزي. فهي عليمة بأمزجة الألوان وطبائعها حين تأتلف وتتكامل وحين تعبق وتترسب وتتبخر، فتأخذنا إلى البعيد أو تلفظنا على الشاطئ.
رسم كالغناء
جان خليفة يرسم كما يغني الطير. أمام مرآته دوماً وجوه نساء ضمن مساحات متقاطعة لتأليف مناخات لونية تعبيرية مختزلة. كأن المرأة هي الشمس التي لا تغيب عن حياته وأعماله، وهذا التعلق بحضورها وجسدها في حياته وفنه، جعله في حالة إنتاج دائم منبثق من إلهاماتها وطيف وجودها المكلّل بالرغبة، ولو كان وجوداً رمزياً غير أنه يحمل كل ألوان الحدائق وصباحات الطبيعة المشرقة بالنور.
إنه يرسم وجهها الذي يعرفه حتى لو لم يره، ويرسم جسدها كما لو أنه يلمسه بريشته وينحته بأصابعه، ويحتفل بها احتفال العاشقين ويحيطها بكرنفالات لونية من شتى الألوان.
يحاكي جان خليفة الشكل بأسلوب محدث بعيد من المبادئ الأكاديمية التقليدية. هذا الأسلوب الذي لا يهتم بتصوير هيئات الوجوه أو تفاصيل القامات، بل يسعى إلى الإيحاء بها، من خلال التظليل الخطيّ والتعقيب اللوني، اللذين يقومان ببلورة أفكاره حول الجمال الذي لا يكتمل إلا بحضور الأنثى رفيقة أوقاته. غير أن التعلق بالمرأة كموضوع شكّل له بطريقة غير مُعلنة مصدر صراع ما بين الواقع والتجريد، ظلت نتائجه غير محسومة إزاء مسألة حضور الشكل وغيابه.
لعل هذا السبب الذي جعل جان خليفة ينحاز في أسلوبه إلى التجريد اللاشكلي Non- Figuratif الذي لا يمحو الواقع كلياً، قبل أن ينصرف إلى التجريد الغنائي Abstraction Lyrique المعتِمد على دينامية الحركة في الفضاء، المرتبطة بعصب اليد والعفوية المطلقة في محاكاة طبيعة الخطوط والبقع والضربات اللونية وتموجاتها وانقلاباتها، بعيداً من مفردات الواقع والتشخيص للحقيقة المرئية.
كل ذلك كان ممكناً بفضل مَلَكة التلوين التي تميزت بها ريشته قوله: “أرسم كما يغني الطير” (وهي شعار مونيه رائد الانطباعية الفرنسية) مشيراً إلى الحرية المطلقة في انصرافه إلى محاكاة العالم من حوله: “أما اللون فهو في جميع أعمالي له الأولوية وغير منفصل عن الشكل، إنه مادة حيّة ترافق ظهور الأشكال، لذا أريد اللوحة متنوعة متطورة غنائية، تمتد وسع الفضاء، حتى إذا تأملتَها عن بعدٍ تتجمع في وحدة تأليف وإيقاع، ومن قرب تغمرك بانعكاسات لونية قوية”.
إذا عدنا إلى بداياته فسنجد بأن تأثّره بانطباعية أستاذه قيصر الجميّل في الأكاديمية اللبنانية (1947- 1950)، كانت سبباً في اكتشافه لتأثيرات اللون في الطبيعة وقدرته على التعبير ليس عما تصفه العين فحسب، بل عن مشاعر القلب وطراوة الحلم وإيقاعات حركة الأشكال وجمالياتها.
فاللون كان الحافز الأول الذي انطلقت منه ريشته تستلهم مناظر الطبيعة في قرية حدتون (مسقط رأسه – قضاء البترون)، لتأتي من بعدها رحلة الاكتشاف والتّعلّم في باريس، حيث تتلمذ على يد الفنان التجريدي غوتز، وتأثر بجنون ضربات فان كوخ وقوة التلطيخ في أعمال نيكولا دو ستايل وجان بازان، والانفعال الحركيّ في لوحات شنايدر وهارتونغ متأثراً على وجه الخصوص بأداء جورج ماتيو.
ثمة لوحة ذاتية له رسمها الفنان في بدايته موقّعة عام 1949، ولعل من أجمل اللوحات الصغيرة التي تركتها ريشته هي الصورة التي رسمها لرفيق دربه الفنان شفيق عبود بضربات لونية جريئة مفعمة بالحيوية. فقد كان ودوداً محباً لأصدقائه الذين رسمهم بعفوية ظاهرة تنم عن قدرته في التعبير وسرعته الخاطفة في التقاط ملامح الشخصية وسماتها المميزة.
في المعرض لوحات عدة لموضوع العارية تعود إلى سنوات ما قبل الدراسة في باريس وما بعدها. أما تأثيرات حرب السنتين وتداعياتها فهي تظهر في إحدى لوحاته التي تجسد مشاعر الخوف والقلق الإنساني العميق، الذي ينعكس على تعبيرات العينين والترقب للمجهول. اللافت في المعرض اللوحات التي تعكس المقدرة التلوينية لخليفة وعصبية لمسته وقوة ارتجاله في التجريد الغنائي، حيث تطغى الحركة المكوكية لريشته وهي تفكك مشهد الطبيعة إلى لطخات وشلالات بقعٍ وأنوار زاهية.
وإن كان ثمة كلمة سرّ أو لغز فني يتركه الفنان بعد رحيله، فهو كما يبدو لي، كامناً في لوحة ذاتية صغيرة يصوّر فيها نفسه، رافعاً يمينه وقد نبتت من أصابعه حزمة من ريش الرسم، وفي كفه عَينٌ سحرية هي عين الفنان المفتوحة على العالم والتي ستبقى شاهدة على الزمن.
المصدر : النهار العربي – مهى سلطان