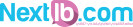حاورتها إكرام صعب
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتقاطع فيه الأسئلة الوجودية الكبرى، تطلّ الكاتبة والأكاديمية الدكتورة منى الشرافي تيّم بروايتها الجديدة “أقدار مشفّرة”، لتُعيد طرح السؤال الأزلي: هل نحن من يتحكم بمصيرنا، أم أن هناك قوى أكبر منا ترسم تفاصيل حياتنا؟
بين العقلين… يتسلل القدر
في “أقدار مشفّرة”، تفتح تيّم نافذة على جدلية معقدة تجمع بين العقل البيولوجي والعقل الإصطناعي، بين الذكاء البشري والآلة، في عالم بات فيه الإنسان قادرًا على بناء أنظمة تحاكيه، بل تتفوّق عليه. وسط هذا التطور، يبرز “القدر” كقوة غامضة، حاضرة رغم كل أدوات السيطرة والبرمجة.
الرواية، بأسلوبها الفلسفي والسردي، لا تكتفي بعرض التقدم العلمي، بل تغوص في العلاقة بين العلم والفلسفة والروحانية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول معنى الوجود، الحرية، الحتمية، وحدود التحكم البشري في الحياة.
ومن المقرر ان تُطلق الرواية الصادرة عن الدار العربية للعلوم- ناشرون. رسمياً يوم الخميس 24 تموز 2025، خلال حفل توقيع يُقام في قصر الأونيسكو – بيروت، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي والفكري.وتحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، والدعوة موجّهة لعشّاق الأدب والفكر والباحثين في قضايا الإنسان المعاصر.

توقيع جديد في رصيد غني
“أقدار مشفّرة” هي رواية جديدة في مسيرة الدكتورة منى الشرافي تيّم، بعد:
• وجوه في مرايا متكسّرة (2010، 2011)
• مرايا إبليس (2011)
• مشاعر مهاجرة (2012)
وتتميّز الرواية الجديدة بقدرتها على المزج بين العمق الفكري والتشويق السردي، ما يجعلها عملًا أدبيًا وفكريًا في آن.
موقع nextlb التقى الكاتبة الدكتورة الشرافي تيم وكان معها الحوار التالي :
1- ما الذي ألهمكِ لكتابة رواية “أقدار مشفّرة”؟ وهل هناك تجربة شخصية أو حدث واقعي دفعكِ للتفكير في هذا الموضوع؟
*ما ألهمني لكتابة رواية “أقدار مشفّرة” لم يكن حدث بعينه، أو لحظة زمنية محددة فحسب، بل تزاحم عدد كبير من التساؤلات والانفعالات والتأملات وتراكمها؛ فهي أشبه ما يكون بعملية تدوير للزمن أو إعادة نحته. نحن نعيش في واقعٍ متشظٍ، تتنازع فيه التحولات المتسارعة، على وجه الخصوص تلك القادمة من رحم التكنولوجيا، التي باتت لا تغيّر عاداتنا فحسب، بل تغيّر وعينا للأمور، وطريقة رؤيتنا لأنفسنا، ومدى إدراكنا لمعاني القدر وأبعادها الغيبية.
وبكل تأكيد لم تكن تجربة شخصية محددة، بقدر ما هو شعور طاغٍٍ بأن الإنسان المعاصر أصبح محاطاً بشيفرات غير مرئية، تحرّكه، وتسوقه سوقاً إلى حيث تريد، وربما تُوهمه بأنه مُخيّر، بينما هو في الحقيقة مسيَّر ضمن سياقات الحياة ومن قلب القدر.
كتابة الرواية كانت السبيل الذي لجأت إليه في محاولة مني لمقاومة كل هذا الغموض المخيف الذي يحيط بنا… فاستخدام الخيال الروائي من خلال اللغة يساعد على استشعار المصير، ليس لكونه يسير على خطٍ مستقيم، بل كشبكة من الاحتمالات والتكهنات التي تصيغها الأرواح أكثر مما تسرده من أحداث. أنا ككاتبة لا أعتمد على نقل الواقع، بل أعمد إلى إعادة تشكيله في عالمٍ موازٍ، تنبض فيه الشخصيات بألآمها، وإخفاقاتها وأفراحها ودهشتها، إلى درجة قد يُخيّلُ فيها للقارئ أنها خرجت من الصفحات لتحيا بيننا.
لا تزال الرواية من وجهة نظري هي الفن الوحيد المرن القادر على الإمساك باللحظة الهاربة، وتحويلها إلى عدد من التساؤلات والاستفسارات الطويلة الأمد. ولهذا السبب، فالفن الروائي منذ نشأته لم يبهت، ولن يخفت، وكلما تسارع إيقاع العالم، ازدادت حاجتنا إلى هذا النفس الإبداعي التأملي الذي تمنحنا إياه الصورة من خلال اللغة الوصفية النابضة.
2- كيف بدأت فكرة الجمع بين الذكاء الإصطناعي ومفهوم القدر؟ وهل كانت الفكرة فلسفية في الأساس أم تقنية؟
وهل الرواية انعكاس لمخاوفكِ من تسارع التكنولوجيا؟ أم احتفاء بإمكاناتها؟
*وُلدت فكرة الرواية على مفترقٍ بين السؤال الفلسفي العميق وبين الدهشة التقنية المعاصرة. مع مرور الزمن شغلتني فكرة “سطوة الذكاء الاصطناعي” أهي قادرة على التحكم في مصائرنا من خلال العقل البشري؟ أم هي قوة خارجة عنه؟ وعندما بدأ الذكاء الاصطناعي في اقتحام كل ما هو إنساني، وجدت نفسي أمام سؤال جديد: هل يسير الذكاء الاصطناعي محاذياً للقدر؟ فالتغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي كبيرة جداً ومدهشة للبشر، فقد حلّ محل ما يقوم به الإنسان في مناحٍ عديدة، وكثيراً مما لا يمكن للإنسان القيام به.
العقل الآلي، مهما بلغ من دقة، فهو ثمرة اجتماع عددٍ لا يُحصى من العقول البيولوجية، التي تنتمي لمشارب وثقافات متباينة، اجتمعت لتصنع الآلة في مختلف المجالات… لكن انبهار البشر بذكاء هذه الآلة جعلهم يبتعدون عن الروح والعاطفة والإيمان واليقين… وعن تلك الحقيقة التي تقف فوق كل شيء وهي (القدر)… أقتبس من الرواية:
“قد تمنحنا الحياة بعض خِياراتِها فهي كالأُحْجيّة، التي نمتلك بعضاً من أجزائها، أمّا الأقدار فتسبح في ملكوت معاكس جبّار، مُحيّر للذِّهن اليَقِظ… إنْ هي أرادت ليس مُهمّا ما نريد! ولو أتتِ التضحيات الجسيمة طَوْعاً، فلا بدَّ من بعض العوالق التي ليس لنا عليها إرادة”
الرواية لم تكن يوماً احتفالاً أعمى بإمكانات التكنولوجيا، ولا إعلاناً عن الخوف منها. فهي أشبه بمحاولة لالتقاط التوازن الهشّ بين الدهشة والتحذير. فالذكاء الاصطناعي من وجهة نظري، يُنتج واقعاً جديداً، يبهجنا بإمكاناته، ويُربكنا بتبعاته.
هذه هي المفارقة التي حاولت الرواية إضاءتها: ففي قلب الذكاء الخارق فراغ روحيّ قد لا تملأه كل المعادلات. وأن الإنسان، مهما بلغ من تطوّر تقني، لا يستطيع أن يُبرمج مصيره كما يبرمج الآلة. فالقدر، في نهاية المطاف، لا يمكن التنبؤ به أو احتواؤه
أما الفلسفة بالنسبة إلي فهي أسلوب حياة، هي العدسة التي أُطلّ بها على العالم. الفيلسوف يُعيد صياغة المفاهيم ورسم أبعادها من خلال رؤى وظلال، يمرّرها من خلال الشخصيات والأحداث واللغة حتى تبدو الرواية وكأنها مرآة عاكسة للوعي الإنساني في مكانه وزمانه.
في “أقدار مشفّرة”، لم يكن الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تُستخدم في السرد فحسب، بل كان حافزاً لسبر أغوار تساؤلات كبرى… الإجابة عنها فتح الأفق لاستفسارات عميقة.
أنا لا أخشى التكنولوجيا، بل من طريقة تلقّيها. ما يخيفني هو حين تُصبح بديلاً عن العقل والعاطفة والإيمان. حين تُمجَّد الآلة إلى درجة تُلغى فيها الروح.
ربما يظن بعضهم أنني ضدّ التكنولوجيا، لكن الحقيقة أنني أراها ضرورة ملحّة لا يمكن الاستغناء عنها. لقد خلق الله البشر بقدرات مذهلة، الفنية منها والعلمية. والتكنولوجيا هي إحدى صور هذا التجلّي البشري العظيم. غير أن القيمة الحقيقية تظهر عندما نُحسن استخدامها. فالموت قدر محتوم، أما المعرفة فباقية، ترثها الأجيال عبر آلةٍ تحفظ الذاكرة وتستأنف الرحلة، فالبشر يموتون، أما الآلة فتبقى…! تحفظ ما أنجزه العقل الإنساني، وتُمهّد لمن يأتي بعده ليكمل السعي.
وهنا بالضبط يكمن الجانب المضيء في الذكاء الاصطناعي: أنه ليس بديلاً عن الإنسان، بل هو امتداد له.
3- تطرحين في الرواية تساؤلات عن مصير البشرية… برأيك، هل نحن فعلاً نملك حرية اتخاذ القرار، أم أن كل شيء مُقدّر مسبقاً؟
*-السؤال عن مصير البشرية هو أكثر ما يشغلني في الوقت الحالي… لأن الخطر لم يعد فقط من “آلة ذكية” تجتاح عالمنا فقط، وإنما من عقل بشري مهووس بالسيطرة، يمتلك الثروة، ويوجّه التكنولوجيا وفقاً لمصالحه. والمخيف أن مستقبل الشعوب بات يُرسم في غرف مغلقة، من قبل قلة تتحكّم بمفاصل الاقتصاد العالمي، ومن ثمّ مفاتيح التكنولوجيا والإعلام والتوجيه النفسي الجماعي. إنهم لا يبنون العالم كما يجب أن يكون، بل يصنعون عالماً موازياً يتناسب مع مصالحهم، ويحصر البقية داخل وهم الاختيار الحر.
نحن اليوم بكامل إرادتنا دخلنا إلى هذا السجن الرقمي الكبير: الهاتف النقال، والمنصات، والشبكات العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، من دون أن نؤمّن لأنفسنا مخارج للطوارئ. ولو انهارت هذه المنظومة فجأة، فإن العالم بأسره سيتوقف… ولن ينجو سوى أولئك الذين فكروا مسبقاً: كيف يعيش الإنسان خارج الشبكة؟ كيف يفكر من دون تعليمات؟ كيف يقرر من دون توجيه خفي؟
أما عن حرية اتخاذ القرار، فأؤمن بأنّنا نمتلكها، ولكن ضمن هامش ضيّق، مشروط. نتمتع بحريتنا إذا امتلكنا أدواتها من خلال المعرفة، والتفكير النقدي، والإرادة، والقدرة على الاختيار في زمن الخداع. أما من حُرم من كل ذلك، فهو يتحرك ضمن خطّ تمّ رسمه سلفاً، وإن توهّم أنه يختار.
الرواية تحاول تفكيك الجدال الدائر بين القدر والقرار، بين المكتوب والممكن. وللتعبير عن فكرتي بهذا الشأن أقتبس من الرواية:
” أنت في عملِك تبرمجين عقلاً للآلة الجامدة، وهذا ما يُطلقون عليه اسم الذكاء الاصطناعيّ أو الآليّ! أمّا الفكر والعقل فهو أنت، والآلة الذكيّة بكلّ قدراتِها تفكّر منْ خلالك. لذلك ما عليك معرفتُه والإيمان بهِ، هو أنَّ العقلَ البشريَّ، والذكاء البيولوجيّ من صُنْع الخالق، الذي يُدبّرُ هذا الكونَ ويُديرُهُ كيفما يشاءُ! وما نحنُ فيه ليس بأكثر من ذرّات من غبار…! ولكنْ ما يجهلُهُ معظمُ الناس، أنَّ الأفكار التي تدور في الرأس، ليست أمراً عابراً فَحَسب، بلْ هيَ طاقة، إنِ اجتمعَت، تتكوّن لديها فاعلية على تحريك الساكن وتليين الجماد، كما أنّها قادرة على تكوين عمليات الجذب منْ خلال مكنونات العقلِ الباطن، فما نريدُه بقوّة يحفظُه العقل، وأكثر ما نخشاه يخزّنُه العقل، ثم تنفِّذُه الأفكار مستعينةً بنوعٍ خاص منَ الطاقِة الروحيّة، وهي ليَستْ موجودة عندَ الجميع، بل عندَ بعض الذين ميّزَهُمُ اللهُ منْ غيرهم، لسبب لا يعلمُه إلّا هُو”.
4- كيف ترين العلاقة بين العقل البيولوجي والعقل الآلي؟ هل يمكن للآلة أن تتجاوز الإنسان في التفكير والشعور؟
*-العلاقة بين العقل البيولوجي والعقل الآلي معقّدة ومُربكة… إنها علاقة على قدر كبير من الإعجاب، والمنافسة، بالإضافة إلى الخطر الصامت. فالبشر يجهدون في صناعة آلات تفكر وتقرر وتُحاكي حاجات الإنسان، لكنهم لم ينتبهوا إلى أنهم في هذا السعي المحموم، بدأوا هم أنفسهم يتجردون من إنسانيتهم… أقتبس من الرواية: “فمَن منهم يصنعُ الآخر؟ هم يملكون المال، ولكنْ ليس للإفادة بما يمكن أنْ يؤمّنه توافر المال منْ مُتَع الحياة، بل يُنفقون المال ليصنعُوا عالماً موازياً للعالم، وإنساناً موازياً للإنسان. عواطفُهم أصبحَتْ باردة، لها أوقات محدّدة! فالآلةُ باردة، فلم لا يحاولون أنْ يجعلوا لتلكَ الآلة عاطفة؟ فربُّما يعودُ إليهم شعورُهم بالحياةِ!”
أما السؤال الذي يفرض نفسه هنا… هل يستطيعون أن يجعلوا للآلة روحاً تشعر وتحس وتبدع أشياء جديدة لم تتمّ برمجتها؟ فالعقل البيولوجي ليس مجرد آلة تفكير، بل هو كيان يخطئ، ويشك، ويشعر، ويتذكر، ويحنّ… وهذا ما لا يمكن برمجته بالكامل. قد تتفوّق الآلة في السرعة، في الحسابات المعقدة، وفي التخزين، وربما حتى في التحليل المنطقي. لكنها تفتقر إلى التقلّب العاطفي كالحدس والحب والحنين والشوق والرغبة… وهذه كلها ليست وظائف عقلية فحسب، بل هي روحية وشعورية.
فالآلة تبتكر داخل حدود ما زُرع فيها، حتى لو بدا ذلك خارقاً. أما الإنسان، فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يُنتج ما لم يتعلّمه… فهو القادر على تحويل الألم إلى قصيدة، والفقد إلى معنى، والموت إلى خلود، والحب إلى مشهد تجتمع فيه إبداعات الخالق.
وهذا ما يجعل الإنسان، بكل تناقضاته، لا يزال أعقد من أن يُختصر في برمجة أو تطبيق إلكتروني.
5-في رأيك، هل التوصّل إلى “حقيقة” الوجود ممكن من خلال العلم فقط؟ أم أن الروحانية لا تزال ضرورية؟
*- لا أؤمن بأن العلم وحده قادر على كشف حقيقة الوجود. فالعقل أداة عظيمة، لكنه محدود بطبيعته البشرية، بينما الوجود أوسع من أن يُحاط بالمعادلات أو يُختصر في النظريات. الروح الإنسانية، تبقى البوصلة الوحيدة القادرة على التقاط ما لا يُرى، وما لا يمكن قياسه أو إثباته، لكنها تشعر به وتتجاوب معه في أعماق الوجدان.
أما الآلة، فمهما بلغت من تطوّر، تبقى من صناعة العقل البشري، لا الروح. قد تساعد في إيقاظ التأمل، لكنها لا تخلق الدهشة، ولا تمنح المعنى. الدهشة هي من خصائص الروح، والبحث عن المعنى هو ما يُميّز الإنسان من كل كائن آخر. هناك دوماً صدفة إلهية، أو لحظة توهج، أو ومضة إلهام تضع الإنسان على درب الاكتشاف، كما حدث مع أعظم المخترعين والمفكرين على مر الزمن.
ولذلك دعوت، من خلال “أقدار مشفّرة”، إلى مراجعة التاريخ ليس من أجل إعادة سرد الماضي، بل كونه الرمز السرّي لفهم ما نحن عليه اليوم ولماذا؟ فالتاريخ مع العلم والروح من نسيج الوجود، ونحن ككائنات مكلّفة بالشعور، نمشي بخطى مترددة بين التسيير والتخيير… وهذا هو التحدي الأكبر الذي حاولتُ أن أضعه أمام القارئ: كيف نكون أحراراً في عالم قد كُتب الكثير فيه مسبقاً؟ أقتبس من الرواية:
ما أنْ وطأتْ قدماها المكانَ حتى بدأَ الهمْس يتردَّد في أذنيها: “أرواحنا هائمة على مفارقِ الأقدارِ، غارقةٌ في رُدِهاتٍ بينَ الأرضِ والسماء، فالأسرار كالحممِ في غليانِها تكبرُ فينا، وتأبى أنْ نحظى بالسلام. فالشرُّ في الأرواحِ لا ينتهي بالموت، كذلك الخيرُ في الأرواحِ يبقى إلى أنْ تنتهيَ المَهَمَّة… نحنُ أرواحٌ اتّحَدَتْ لحمايتِكِ! وحولَنا أرواحٌ اجتمعتْ كي تَجْلُبَ لكِ الشرَّ والبؤس”.
6- إلى أي مدى ترين أن الذكاء الاصطناعي يغيّر من هويتنا كبشر؟ وهل هذا التغيير إيجابي أم سلبي؟
*- للأسف، ما أراه اليوم هو الوجه القاتم للتطور. فالذكاء الاصطناعي، على الرغم من تفوقه التقنيّ، قد يُستخدم لتزييف الواقع والابتعاد عنه. أصبح الإنسان يختبئ خلف واجهات رقمية، ويحرّف صورته، ويُعيد تشكيل صوته، ويُزيّف مشاعره، حتى بات يُمارس نوعاً من التحايل على ذاته… انفصال طوعي، يشبه النوم في فقاعة لذيذة، لا تحمل وجهة، ولا تسعى إلى غاية.
وما يُقلقني بشدة، كأستاذة جامعية، هو ما أراه لدى الجيل الحاضر: عزوفٌ شبه كامل عن استخدام العقل النقدي. أصبح الذكاء الاصطناعي يفكر بدلاً عنهم، ويكتب، ويقرّر، ويُبهِر، حتى بات بعضهم يسلّم له زمام أموره. هنا، لا نتحدث عن مجرد أدوات مساعدة، بل عن فقدان أدوات الوعي نفسها: التحليل، والإبداع، والقدرة على الربط، واستشراف المعنى… كلها تتآكل.
الأخطر من كل ذلك، أننا أصبحنا متشابهين. نقبع في قوالب رقمية متطابقة، فتلاشت الفروقات الفردية، وفرّغت الإنسان من خصوصيته. وهو ما يُهدد جوهر الهوية البشرية، التي لا تُبنى بالعقل فحسب، بل بالاختلاف، وبالقلق، وبالبحث عن الذات وسط كل تلك الفوضى.
الرواية بالنسبة إلي، في هذا السياق، هي مقاومة. مقاومة لسطوة الآلة، وتذكير بأن الإنسان ليس مجرد مستخدم للتقنية فحسب، بل هو كائن يبحث عن المعنى، وعن الله، وعن الحب، وعن حقيقته… وهذا ما لا يستطيع أي تطبيق أن يفهمه كما يجب.
7- كيف تفسّرين التصادم بين التكنولوجيا المتطورة ومفهوم “القدر” في الرواية؟ من ينتصر في النهاية؟
*- هو ليس تصادماً بما تعنيه الكلمة، فهي من صنع الإنسان، وفي كثير من الأحيان وُلدت من رحم الصدفة. وهذه الصدفة، في معناها العميق، ليست عبثاً، بل هي أحد وجوه القدر. الله يزرع إشاراته على دروب البشر، ولكن ليس الجميع يملك البصيرة لالتقاطها. هناك من يمرّ بها مرور العابر. وهناك من ينحني ليلتقطها فيجعل منها شرارة للخلق والإبداع.
الفارق إذن، ليس في الصدفة ذاتها، بل في الوعي بها. فبعضهم يرى النواة في داخل القشرة، وبعضهم لا يرى إلا القشرة. وهنا تكمن الفروق بين العقل المبدع والعقل المستهلِك، بين من يبذر المعنى، ومن يكتفي بالتلقي.
أما من ينتصر؟ فالانتصار لا يُقاس بالتفوّق التكنولوجي ولا بالتقدم الرقمي، بل بالبقاء على إنسانيتنا. المنتصر هو من لم يفقد دهشته، من بقي يؤمن، من وسّع في داخله مساحةً للروح كي تحلّق في هذا الكون المترامي وتسأل: من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟
القدر، في النهاية، أقوى من كل حسابات الذكاء الاصطناعي. هو القادر على أن يُسقط أعقد البرمجيات قبل أن يرفّ الجفن. في “أقدار مشفّرة”، لم يكن السؤال: من سينتصر؟ بل: من سيبقى إنساناً حتى النهاية؟
8- هل ترين أن الذكاء الاصطناعي قادر على اتخاذ قرارات أخلاقية؟ أم أن ذلك يظل حكراً على الإنسان؟
*- كما أشرت سابقاً، فالذكاء الاصطناعي هو آلة، مهما بلغت من التطور، تظل مجرّد حاوية ضخمة للبيانات، تعمل على أساس التحليل والتكرار والتوقع، لكنها لا تفهم المعنى كما نفهمه نحن. قد تتمكن من محاكاة القرار، أو استنساخ السلوك الأخلاقي، لكنها لا تشعر به، ولا تتوقع عواقبه على مستوى الروح.
إن اتخاذ القرار الأخلاقي ليس مسألة حسابية، بل هو فعل ثقافي وروحي عميق، يُبنى على الإحساس بالمسؤولية، وبالشفقة، وبالخوف من الله، وبالضمير، وكلها أشياء لا تسكن في الرقائق الزئبقية، بل في قلب الإنسان.
الذكاء الاصطناعي، وإن بدا حاكماً معنوياً للعالم اليوم، لا يستطيع أن يكون مرجعاً أخلاقياً حقيقياً، ببساطة لأنه يفتقد الروح. وكيف لمن لا يملك شيئاً أن يمنحه؟ فالقرار الأخلاقي ليس معلومة تُسحب من قاعدة بيانات، بل لحظة إنسانية خالصة، يصعب حتى على الإنسان أحياناً أن يحدد فيها الصواب من الخطأ… فكيف بآلة؟
ولذلك، تظل الأخلاق حكراً على البشر. لا لأننا كاملون، بل لأننا ناقصون وعلى وعي تام بهذا النقص، ونحن نحزن ونندم ونتوب ونرضى. وهذه القدرة على الندم، وعلى اختيار الخير رغم صعوبة الطريق، هي ما يُميزنا… وهي ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يُحاكيه أو ينافسه مهما تطور.
9- ما التحديات التي واجهتكِ أثناء كتابة هذا النوع من الروايات التي تمزج بين الفلسفة والخيال العلمي؟
*- التحديات كانت هائلة، ووجودية في بعض اللحظات. فكتابة رواية تمزج بين الفلسفة وبين الخيال العلمي هي بمنزلة الوقوف على جسر معلّق بين المعلوم والمجهول، وبين المنطق والحدس، وبين ما يحدث فعلاً وما قد يحدث غداً. ولو لم أتحلَّ بالصبر والإرادة والعناد والإيمان بما أكتب، لما رأت “أقدار مشفّرة” النور.
بدأت كتابة الرواية في سنة 2019م، وكنت أظن بأنني أشطح بخيالي بعيداً… لكن المفارقة أنني كثيراً ما كنت أستفيق على واقع يسبقني بخطوات! ما كنت أكتبه كخيال علمي في الليل، يتحوّل إلى خبر علمي في الصباح! فشعرت أحياناً أنني لا أكتب عن المستقبل، بل ألاحقه. ووسط هذا السباق المحموم، كنت أضطر للتوقف، وللتأمل، وللتفكير: هل أواصل؟ أم أترك الخيال يستسلم للواقع؟
عند مفترق الطريق، كان القرار الأصعب: إما أن أتنازل عن الرواية، وأقرّ بأن التكنولوجيا قد هزمتني ككاتبة، أو أن أستمر في خلق عالمٍ تتقدم فيه التقنية، لكن تظلّ الروح فيه متربعة على العرش… وهنا تسلّح خيالي بالقدر، لأنه كان الفضاء الوحيد الذي لا تستطيع التكنولوجيا اختراقه، بل لا خيار لها سوى أن تخضع له.
لم يكن الطريق سهلاً. في كثير من الليالي شعرت بأنّ الإبداع يتخلى عني، وأنني أكتب في العدم، لكن في لحظات دقيقة شعرت وكأن شيئاً من الإلهام الإلهي يرافقني، كما لو أن هناك “قدراً” يكتب معي… ولذلك حين انتهيت من الرواية، لم أشعر فقط بأنّني أنجزت عملاً أدبياً فحسب، بل شعرت بأنني وُلدت من جديد. هذه الرواية كانت لي أماً وابنة في آنٍ معاً… ولدتني حين أضعت ذاتي، وولدتُها حين كانت تهرب مني. إنها جزء من روحي، لا من حبر قلمي فقط.
10-هل تعتقدين أن البشر سيتخلّون يوماً عن قراراتهم لصالح “عقل خارجي” ذكي؟
*- أعتقد ذلك حقاً… فالكثيرون بالفعل قد تخلّوا عن قرارهم، وغاصوا في سلطة العقل الخارجي الذكي البديل، الذي أصبح يتحكّم بتفاصيل حياتهم الصغيرة والكبيرة. لكن الباقين على الطريق، هم أولئك الذين يشبهون شخصيات روايتي، هم آخر الحُماة لهويتنا الروحية والعقلية. هم الذين سيحافظون على خصائص الاختيار الحر، وينقلونها بكل صدق وجرأة لمن يأتي بعدهم. وهؤلاء وحدهم هم الأمل في عالم يزداد فيه حضور الآلات، ولكن لا يمكن لأيّة آلة أن تحلّ محل روح الإنسان، أو أن تحلّ مكان قراره، طالما بقي هناك من يؤمن بالذات، ويقاوم الانصياع الأعمى.
أما الأمل فليس في التكنولوجيا، بل في الإنسان الذي لم يفقد إيمانه بقدرته على الاختيار، رغم كل ما يُحيط به من صخب وفوضى.
11- ما الرسالة التي ترغبين في أن يحملها القارئ بعد إنهاء “أقدار مشفّرة”؟
*- هذا سؤال يحمل في طياته بساطة عميقة وتعقيدًا رائعًا في آنٍ واحد. “أقدار مشفّرة” لم تكن مجرد رواية أكتبها، بل رحلةٌ غيرت نظرتي إلى الحياة وأعادت تشكيل علاقتي بالله، ذلك الإيمان الذي لا يهتز مهما اجتاحتنا من عواصف في هذا الكون.
رسالتي التي أرجو أن تصل إلى القارئ هي هذا الشعور النقي، ذلك الإحساس بالشفاء النفسي والسكينة التي تغسل القلب والروح. إيمانٌ لا يرتبط بدين معين أو شريعة محددة، بل هو إيمان شامل، يتسع لكل إنسان بكل أطيافه وميوله.
حتى شخصيات العلماء العلمانيين في الرواية، رغم تحفظاتهم، وصلوا في النهاية إلى ذلك اليقين الروحي، لأن الإيمان ليس حكرًا على أحد، بل هو نبع متجدد ينبع من أعماق الإنسان، يدعونا للتوكل على الله القادر على كل شيء، وهو فوق كل شيء.
أتمنى أن يغادر القارئ صفحات “أقدار مشفّرة” بحسّ أعمق بالسلام الداخلي، وبقوة أن الحياة رحلة من الإيمان والحرية والبحث عن الذات في عالم متشابك ومعقّد.
12-هل هناك نية لكتابة جزء ثانٍ؟
*- في الحقيقة، أنا لا أميل إلى تعدد الأجزاء في الرواية. رغم أن “أقدار مشفّرة” انتهت على الورق، وبقيت أحداثها تتكشف على أرض الواقع. ومع وجود الإمكانية لكتابة جزء ثانٍ، إلا أنني أؤمن بأن قوة الرواية تكمن في أصالتها وتفرّدها.
فالتكرار أو الاجترار قد يُضعفان العمل ويُشوهان بهاءه، وقد يؤديان إلى إضعاف الرسالة التي حملتها الرواية. لذلك، أُفضّل أن تظل “أقدار مشفّرة” عملًا متكاملاً بذاته، يتنفس بحرية، ويترك للقارئ مساحة للتأمل في النهاية المفتوحة التي تدعو إلى المزيد من التفكير، بدلاً من سرد جديد قد يُفقدها بريقها.
13- كتاب أثر فيكِ فكرياً؟
*- هناك العديد من الكتب الفلسفية التي تركت آثاراً عميقة في فكري أثناء دراستي وتخصصي في النقد الأدبي، خصوصاً تلك التي فتحت أمامي آفاقاً جديدة في فهم الإنسان وعلاقته بالزمن والكينونة، وهو ما انعكس بشكل كبير على رؤيتي للفلسفة والغوص في مفاصل النفس الإنسانية والخيال العلمي في أعمالي الأدبية. هذا الفهم جعلني أتعامل مع شخصياتي وأفكاري الروائية بعين تأملية عميقة، وبتقدير أكبر للغموض الذي يحيط بكيان الإنسان.
وأنا أشجع الطلاب الدارسين للرواية، الرجوع إلى رواية: “أقدار مشفرة”، وذلك لأنها جمعت بين كل العلوم الإنسانية النفسية والاجتماعية والروحية والفلسفية والسياسية والتاريخية بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والتكنولوجية وعلم الفضاء، حتى لو جاءت على هيئة خيال علمي!
إنها رواية تطرح العديد من التساؤلات… وهذه هي مهمة الأدب الحقيقي.

عن الكاتبة
الدكتورة منى الشرافي تيّم، أكاديمية وأستاذة جامعية، عملت في عدد من الجامعات اللبنانية، أبرزها الجامعة اللبنانية الأميركية (2016 – 2024)، وجامعة بيروت العربية، وتحمل دكتوراه في اللغة العربية وآدابها – اختصاص نقد أدبي حديث. من مؤلفاتها أيضًا أعمال في الشعر الحر والنقد الأدبي وأدب الناشئة، كما شاركت في أبحاث لغوية وثقافية، ولها حضور دائم في الصحف والمجلات الثقافية.